
الأندلس الهاربة
د.عبدالله إبراهيم
وصلتُ الباخرة في اللحظات الأخيرة قبل مغادرتها ميناء طنجة المغربي إلى الجزيرة الخضراء في أسبانيا، فاندهشت بأمواج البحر المتوسط تحتضن أمواج المحيط الأطلسي. موجة تعقب أخرى، فأخرى. تجولت في أنحاء السفينة كالمجنون الذي يريد اقتناص اللحظات، واستندت إلى السياج أتأمل جبال المغرب المشجرة تتوارى شيئا فشيئا إلى يميني. لاحظت أكواخا بعيدة، وسنون جبلية جرداء، وكهوفا، ثم غابات كثيفة. أثارتني المياه الداكنة، والسفينة تشقها منسابة فيتناثر الزبد يميناً وشمالاً، وتراءت لي الأندلس من بعيد ذكرى قادمة من عمق الماضي، أو رغبة خاطئة، تلك الأندلس التي توهجت للحظة، ثم سقطت في عتمة النسيان. وصلت الجزيرة في الرابعة عصرا من يوم12/7 /2001 وبعد أن انزلقت بنا الباخرة إلى ميناء يقع بين جبل طارق وطريف، رمتنا على رصيف حديدي صدئ، فانفرط عقدنا كأننا حفنة زبيب تناثر من زكيبة. مررت من نقطة الدخول متعجلا، لا أرى إلا ما أفكر فيه، ولم أعط نفسي حق اكتشاف الأشياء، فختمت جواز سفري فتاة متثائبة، وأخذت الحافلة إلى غرناطة.
لم أتمهّل لمعرفة الأرض التي وقّّع عليها العرب بخطواتهم الأولى كأنني أفرّ من حدث غامض يتأرجح بين المفخرة والعار، فلم أحسم تأويلي للحظة وصولهم إلى أرض أخرى، والبقاء فيها، لكن مروري الاستكشافي بالأندلس، ورؤيتي لرفعة الأثر، ترك معنى ايجابيا لقضية الأندلس في نفسي، وتشبّعت بالقرون الثمانية التي أقامت صرح تجربة ندر مثيلها في تاريخ العرب. وحينما وصلت كنت فرغت لتوّي من تدريس جامعي لأشعار الغزال، وابن خفاجة، وحفصة الركونية، وولادة بنت المستكفي، ونزهون الغرناطية، ومهجة القرطبية، وابن زيدون، فالأندلس تتّقد في مخيلتي ومضة جمال مبهرة. مررت بـ"ماربيا"ثم"ملقا"بموازاة الشاطئ، وانعطفت ناحية غرناطة في عمق اليابسة إلى الشمال جوار جبل عظيم. فتح المدينة طارق بن زياد في مطلع الثلث الأخير من القرن السابع الميلادي، وقد استعادها الملك فرناندو في عام 1492.
حططتُ رحلي بغرناطة في الثامنة، لست غازيا، ولكنني متشوّف لمعرفة بقايا مجد غابر. واتجهت أول صباح اليوم التالي إلى"القصر الحمراء"فانتظمت في طابور طويل للحصول على تذكرة الدخول. وبدأت الدهشة تتصاعد في داخلي، وأنا في الممر المؤدّي إلى قصور شادها بُناة ضربهم الجمال في أعماقهم. اتجهت شمالا، وعبرت جسراً صغيراً، فانزلقت إلى عالم مبهر: باقة من المباني العريقة، والقصور المترابطة التي يفضي بعضها إلى بعض. تأتي الحمراء من الماضي لتجمع عشرات اللغات، والأجناس، والثقافات. وأمواج السائحين تتداخل فيما بينها، متجمّعة حول الأدلّة يشرحون كل شيء، ويستحضرون الماضي. وتتردد كلمات"العرب"و"المسلمون"في أرجاء تذكّر بأنهم كانوا هنا وذهبوا إلى غير رجعة.
يصغي الأميركيون إلى الدليل، ويبدون دهشة حينما يخبرهم إن كل ما يرون قد شيّد قبل اكتشاف بلادهم، فتتردد شهقاتهم في الأروقة المضاءة بالشمس عبر النوافذ المزججة، والعجائز منهم يشعرون بحاجة إلى التاريخ فيما يظن الشباب بأن التاريخ بدأ بهم، ولا حاجة لهم بذاكرة. وذبت بفوج أصغى، وأتعرّف، وتشرد بي الذاكرة بعيدا إلى الماضي، فأبدو نافرا كمن ينتمي ولا ينتمي إلى هذه اللحظة، ثم فارقتهم في مدخل قصر الناصر، وارتقيت سلماً لأجد نفسي على مقربة من منارة صارت كنيسة يعلوها جرس ضخم، فتأملت فيها طويلاً، وطفت بالقصر الدائري، وتفحصت المنمنات، والأروقة المفتوحة، ودهشت حينما انتقلت إلى الحدائق حيث الأشجار، والنافورات، والممرات المرصوفة بحصى تاريخية، وتصوّرت حال بني الأحمر، وفهمت بعمق المقولة التي طالما قرأتها، حينما خاطبت آخرَ ملوك بني الأحمر أمَُه" إبك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال"ففي هذا الفضاء الخلاب لا يشعر المرء بأنه يملك ثروة، إنما هو جزء من شيء نادر واستثنائي.
لا يمكن فهم الحمراء على أنها قصر، فهي مزيج من الروح الخلاقة والفن العريق، والقوة الجميلة، واللطف الشفاف. ولم أحس بأنها مكان للسلطة، فالجمال قهر كل شيء، شعرت في زيارتي للآثار الأخرى بأنها أماكن للقوة والعنف، كما وقع لي في قلعة"مون سان ميشيل" في النورماندي، وقصر"فرساي"قرب باريس، وقلعة أدنبره في أسكتلندا، وقلعة"الشقيف"في جنوب لبنان، وقلعة"الربض"في عجلون بالأردن، لكن إحساسي بالجمال في الحمراء ذهب بي إلى أنها كانت خلاصة لذوق سام تغلّب على كل شيء. عرفت الحمراء الرفعة والذل، وشهدت أمواج الدهر لقرون طويلة. في البدء بنيت قلعة حصينة للزعيم البربري ابن حبوس، اختارها على مرتفع من الأرض، ليحدّق دائما في غرناطة المرتمية في الوادي، وأحاطها بسور محكم، يحتمي به من صروف الدهر، وعلى الرغم من ذلك انتزعها بنو الأحمر، وأحالوها جنة طوال عهدهم، وحينما خرج آخرهم، أبو عبدالله الصغير، حمل معه رُفات أسلافه ليردم بئر الذكرى، فآل المكان قصرا للملك الأسباني الذي ورث المدينة، وحاز على صكّ استسلامها، فعبثتْ يد التعصب في أرجائها، كما يحدث في كل واقعة حينما يرث دين دينا آخر، فحلّت الكنائس فيها محلّ المساجد، وكشطت الزخارف العريقة، وألقيت في الوادي المجاور، ونُقشتْ محلها زخارف رومانية. ولما رحل ملوك الأسبان إلى مدريد أصبحت الحمراء ثكنة، وما لبثت أن هُجرت إثر انفجار مخازن البارود فيها، فأضحت مهجعا للغجر، وقطّاع الطرق.
وحينما اقتحم نابوليون أسبانيا مطلع القرن التاسع عشر، ونصّب أخاه ملكا عليها، إتّخذ منها جيشه حامية منيعة. وحيكت أساطير كثيرة حول الحمراء، أوردها"أرفنج"في كتابه عنها إثر زيارته لها نحو عام1830، ولم يعد الاعتبار لهذا الأثر المعماري المترف إلا في القرن العشرين، فأصبح أهم معالم الأندلس الأسبانية. أمضيت ساعات خمس في لذة مدهشة، ولما قادني الممر المشجر إلى الخارج كنت بدأتُ أفهم على نحو ما معنى بأن تكون للحياة قيمة، وأخيراً طلبت إلى مرشدة أسبانية أن تصوّرني عند المدخل، شابة في العشرين، شكرتها، وقلت مازحا إن كانت تعرف أن أجدادي هم الذين بنوا هذا المكان. صعقتْ، ودهشتْ، فالعرب بالنسبة لها كائنات موجودة في التاريخ فقط، ويذكرون كجزء من ماضي أسبانيا. عظمة التاريخ غادرة، وعبء يصعب حمله عبر الزمن. عدت إلى مركز المدينة، ثم صعدت جوار الوادي في الجهة المقابلة إلى "ساكرومونته".
فيما توجهت إلى قرطبة بدأت استعيد طوال الطريق غرناطة مرة أخرى. فقد أمضيت اثنتي عشرة متواصلة في التعرّف إليها بعد زيارة القصر الحمراء، فمنذ الرابعة عصرا إلى الرابعة فجرا أتيت على أهم معالم المدينة. إذ زارني صديق فطلبت أن نتوجه إلى الكاتدرائية العظمى، وهي بناء فخم علّقت على جدرانه لوحات أصلية لـ"غويا"و"فيلاسكس"وآخرين، وبدا المسيح مثيراً للشفقة أكثر من الرحمة، فالرموز المسيحية تميل لإبداء الضعف، واستدرار العطف، لكن المفاجأة كانت في القاعة الكبرى ذات الأعمدة الشاهقة، والأقواس القوطية، فبناؤها مركّب، ومثير للرهبة. دخلنا المتحف الصغير المجاور الذي يخلد أعمال الملكين الكاثوليكيين"إيزابيل"و"فرناندو"وتفحصنا هدايا ذهبية وفضية، منها منحوتات لـ"كانو"تتناثر في أماكن كثيرة، إحداها لرأس"يوحنا المعمدان" أنجزت في منتصف القرن السابع عشر، وأثارني سجل كبير باللاتينية خاص بأعمال الكنيسة، ومصروفاتها المالية للفترة1510-1522 ويذكر بمخطوطات العصور الوسطى.
غادرنا الكنسية بعد ساعتين، فتجولنا في الأحياء المجاورة: المدرسة العربية، ثم القيصرية التجارية التي كانت إسطبلا للخيل، وشربنا قهوة، ثم مضينا إلى البوابة الملكية التي دخلت منها القوات الأسبانية حيث استسلم أخر ملوك بني الأحمر، وفي هذه الساحة كان قسيس غرناطة يأمر بقتل بقايا المسلمين إذا رفضوا الانخراط في النصرانية. مررنا بضفاف نهر"الشينيل"الذي يجري تحت المدينة، وقصدنا الحي العربي حيث يذكّر كل شيء بالعرب: الشاي، والموسيقى، والمعمار، فارتحنا لساعة، ويممنا شطر"البايثين"وهو الاسم العربي لحي"البزازين"القديم، ووصلنا إلى معبد القديس"نيقولا"إذ تنبثق منه للرائي القصور الحمراء خلف الوادي، ويظهر قصر كارلوس الدائري، وإلى اليمين"جنة العريف"وقد سطعت المباني تحت الأضواء المبهرة. اغتسلنا، وشربنا الماء من بئر عربية قديمة تتدفق مياهها من صنبورين، ورحنا نخترق الأزقة الضيقة المرصوفة بالحصى ناحية"ساكرومونته"مكان الغجر، وكهوف"الفلامنكو"والطرقات الضيقة. أعلنت الساعة الواحدة ليلاً، وقد بدأت الكهوف تغلق، ولم أحظ برقصة فلامنكو. اتجهنا إلى جزء آخر من الحي العربي حيث مئات الشباب يمرون في شارع ضيق مترنحين، ذهاباً وإيابا، فعثرنا على مطعم مغربي تعمل فيه فتاة صينية، وراقبنا الألفة البدائية لبشر من مختلف الاعراق يمتّعون بعضهم، ويصخبون، ولما غادرنا الحي كان العمال يغسلون الشوارع الضيقة بمياه هادرة كالفيضان. فوصلت فندقي في الرابعة فجراً. تعلّقتُ بغرناطة الغنية بالتاريخ، والبشر، والحياة.
ثم انطلقت سهما منفلتا إلى قرطبة أريد أن أشكّل فكرة عن عالم كنت أعرف عنه قليلاً. فأخذتني حافلةُ حديثة ناحية الشمال الغربي إلى قلب الأندلس، مررنا بكاله، والكوديت، وبابينا، وأسبيخو، ثم قرطبة، وكلما ابتعدنا عن غرناطة الرابضة عند أقدام جبال"سييرا نيفادا"كانت أشجار الزيتون تغطي التلال، وتتكاثر حقول عباد الشمس. فوصلت عصرا، وجررت حقيبتي إلى نُزل"سينيكا"في الحي اليهودي القديم"الخدرية"المجاور لمسجد قرطبة وكاتدرائيتها"المثكيتا". فتحت لي النزل عجوز قصيرة ضاحكة، وأخبرتني بالثمن، ثم قادتني إلى غرفة بيضاء تكاد تندفع شجرة برتقال من نافذتها الوحيدة. استفسرت عن"الفلامنكو"فأخبرتني بحفلة تقام الليلة، واشتريت تذكرة وأنا في النزل.
خرجت أتعرّف إلى المدينة. الحي أبيض، وطرقاته الضيقة مرصوفة بالحصى، وعلى مبعدة مئة متر تنتصب منارة مسجد قرطبة الكبير الذي بناه عبد الرحمن الداخل بعيد وصوله المدينة في عام 755، وتأسيس الحكم الأموي فيها بعد انهياره في دمشق بست سنوات. توجّهتُ إليه عجلاً، فهالني مزيج من الحضارتين الإسلامية والمسيحية، فتداخلت الثقافات فيه: الأعمدة، السقوف، الممرات، والتصميم العام، المنارة إسلامية ولكن اللوحات والهياكل، والمحاريب، مسيحية. وجدت الكنوز الذهبية للكنيسة، والشمعدانات، والنواقيس، والأعمدة التي تذكر بالزيتونة والقرويين، ثم المنارة الشاهقة التي أُزيلت عمامتها الاسلامية، ونصّرت، وعلقت فيها أجراس هائلة. أفعمتُ بروح عمقت فيّ أحاسيس القصر الحمراء.
غادرت المسجد إلى النهر المجاور، وعبرت الجسر إلى الناحية الثانية حيث البرج العربي، إذ استقبلني موظف أعطاني جهازا ناطقا يصف الحضارة العربية في الأندلس: الموسيقى، والعمران، والزراعة، لكن الأمر الذي جذبني على نحو منقطع النظير غرفة الفلاسفة التي تمثل التداخل الثقافي بأجمعه، غرفة فيها من اليمين إلى اليسار: ابن ميمون، ثم ابن رشد، وابن عربي، ثم الفونسو العاشر. مسلمان، ومسيحي، ويهودي. أربعة من كبار رموز الأندلس بأزيائهم القروسطية، وبتماثيل من الشمع الدقيق الصنع. وحينما دخلت كان الحديث لابن رشد، يصل عبر الجهاز، ثم ابن ميمون، وابن عربي، فالفونسو العاشر، وكلهم يعرض موقفه من قضية الحقيقة والشريعة التي كانت من شواغل اللاهوت في عصرهم، فتضاء الأنوار على الشخصية حينما تبدأ في عرض آرائها. لا أعرف لم راقني عرض ابن رشد من بينهم، وحينما ألقيت بحثي عنه في المؤتمر الدولي الذي عقد في القاهرة في ربيع عام 2002 كنت أستعيد ذلك الهيكل الشمعي الذي يجهر بالحقائق العقلية واثقا، والذي جرّ طريدا من مسجد قرطبة، وأُحرقت كتبه، ونُفي إلى مراكش. وجدت مزيجا من العقائد والأعراق في حوار عميق، فأين نحن الآن من هذا التلازم الذي لا سبيل سواه!.
خيّل لي أن ابن رشد وابن عربي أكثر شباباً بين الآخرين، ولم أنس أن ابن عربي كان شاهداً على إعادة جثة ابن رشد من مراكش إلى قرطبة حينما عودلت بتواليفه على دابّة، فأورد في "الفتوحات المكية"قول الناسخ ابن السرّاج"هذا الأمام وهذه أعماله" فقال ابن جُبير الذي حضر ذلك، وكان من خصومه قبل وفاته " نِعم ما نظرت، لا فضّ فوك"وهو القائل حينما كان ابن رشد حيّا"إن تَواليفه تَوالف". في ربيع العام الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي، أُخرجت جثة الفيلسوف من قبرها الذي دفنت فيه، وأُرسلت إلى قرطبة لتوضع في قبر جديد. غادرت القاعة البيضوية وأنا مشبع بحضور أقطاب المدينة، فواصلت صعودي في سلّم البرج إلى أن بلغت سطحه الأعلى، ومن هناك وقعت معظم قرطبة تحت ناظري. تنشقت الهواء القادم عبر السهول المجاورة، ورأيت الجسر القديم بقناطره العربية، والمياه الغرينية الحمراء، والريح تنفث في داخلي لذة الحبور والمتعة، فهبطت، وعبرت الجسر ثانية إلى النزل في الثامنة والنصف. غمرتني سعادة عميقة، فتمدّدتُ قابضا بيدي غصن البرتقال عبر النافذة الخشبية.
وصلتُ محل"الكاردينال"قبيل عرض"الفلامكنو"بدقائق، بعد أن تهت في الأزقة الضيقة والمتقاطعة للمتاهة اليهودية، فوجدت يابانية تشاركني المنضدة التي حجزتها. تجربتي بكرٌ في معرفة هذا الرقص الغجري. ظهرت لي الحركة الأولى سمجة، ومفتعلة، وآلية، للشاب والفتاتين، ولكن عدوى الانسجام المريع سرت إليّ بعد دقائق، حينما اكتشفت أن الفلامنكو يستند إلى الإيقاع بالأرجل، والقوة المحكمة، والانسجام المنضبط، فتناثر تحفظي في الفضاء المفتوح المملوء بالمشاهدين حينما بدأت الرقصة الثانية التي جرتني من برود الملاحظة إلى روح المشاركة الحارة، فانتقل الايقاع إلى دمي. كان رقصاً بارعاً أدّته فتاة ثم اثنتان، فثلاث، وأخيراً خمس برفقة الشاب الأول. لفت انتباهي دفء الإيقاع، ثم حرارته المتصاعدة، والذروات المفعمة بالقوة، وهو رقص مرهق يقوم على الحركة السريعة وضرب الأرض بكعب الحذاء من أجل ضبط الإيقاع، ثم الانتقال السريع، والانحناء، والتقدم، ثم الدوران، والعودة. الفلامنكو ثقافة جسد، وحركة يعبر بها عن جوهر الثقافة الأسبانية التي تبدو لي بشراً وتاريخاً تمتاز بالحيوية.
وفي الصباح انطلقت إلى مدينة الزهراء التي بناها عبد الرحمن الناصر، رأس الجيل السادس من أحفاد صقر قريش، على سفوح جبل العروس بمواجهة قرطبة، خلال حكمه الطويل الذي زاد على نصف قرن، وتوالى أبناؤه على تشييد قصورهم فيها إلى أن انهار ملكهم في نهاية العقد الثالث من القرن الحادي عشر. بدا المكان مهجورا على نقيض الحمراء. تجولت في الأطلال العربية، ولم أشعر باستثارة المنحوتات النقشية فطالما رأيتها، لكن قاعة عبد الرحمن الثالث أعجبتني كثيراً. صمّمتْ الحدائق وكأنها الفضاء المكتمل للقصور، ولكن الدهر غدر بكل شيء، وحيثما يكون ثمة مجد أجد في نفسي إحساساً بالزهو. أمضيت وقت الضحى أتعقّب خطاي في متاهة من خرائب التاريخ كالباحث عن وهم، وعدت ظهرا بالحافلة عبر طريق ضيق معبّد، تناثرت على جانبيه قطعان من البقر والماعز، ولما التفت ظهرت الزهراء لوحة باهتة ارتسمت على صدر الجبل. أرغب في التعرف إلى قرطبة في نهاية الأسبوع، فخلدتُ إلى راحة القيلولة استعداداً لليل. وغادرت غرفتي في الخامسة والنصف. خرجت من المكان المفعم بالتاريخ. ابتعدت عن الخدرية، واتجهت إلى قرطبة الحديثة. الشوارع خالية فاليوم هو الأحد، تجولت بين مبان جميلة، وفي شوارع مرصوفة بالطابوق. مررت بحديقة مزهرة، ونافورة تقذف سلسلة فضية من الماء نحو السماء، ثم عبرت طرقات بدت واسعة إلى شارع رئيس آخر، وعدت من الجهة الثانية، وجلست في الساحة الكبرى حيث النافورات والفارس المسيحي أعلى النصب.
أردت صباحا إلقاء نظرة أخيرة إلى قرطبة، فتوجهت إلى القصر"الكاثار"وسط الحدائق الغناء، وغادرت النزل إلى محطة الحافلات ظهرا باتجاه أشبيلية عاصمة مملكة بني عبّاد. استغرق الطريق ساعتين إلى الغرب، أقمت في نزل"سان بنيتو"جوار المنطقة العتيقة"سانتا كروث"وخرجت في الخامسة أتعرف إلى المدينة التي فتحها موسى بن نصير. زرت الكاتدرائية العظيمة"الخيرالدا"وتوجهت إلى ساحة"نافيو"حيث ارتحت قليلاً، ومررت بشوارع ترشح بالتاريخ والمهابة، رأيت"الأرشيف الهندي"الذي يحتوي وثائق الفتح الأسباني لأميركا الجنوبية، وتذكرت كولومبس الذي زرت تمثاله في قلب غرناطة. مررت بقصر"سان فرناندو"الذي أصبح مكتباً للبريد، الأمر الذي يؤكد تقلّب الأقدار، واتجهت ثانية إلى"سانتا كروث"التي تشبه"الخدرية" لكنها ذات مبان شاهقة. أعشق الأحياء القديمة لمقاومتها الزمن، ولفتنة الشرفات المشرعة على الريح، والنوافذ الزرق، والمقاهي المرمية على الأرصفة الحجرية، والنادلات بالملامح الغجرية. سمراوت البحر المتوسط اللواتي لا يقاومن.
عدتُ إلى النُزل مرهقا، فغطست في نوم عميق قطعة كابوس، إذ وجدتني أعترض قطارا هائجا بجسدي، فاستيقظت ظمئا، ودرت في باحة النزل مترنحا أبحث عن ماء، أعاد الماء القراح روعي، فانتظرت إلى الصباح عبثا زيارة النوم. ولى دونما رجعة، وبقيت في انتظاره وحيدا، تائها، لكنني عازم، وراغب، وقوي، وعارف بما أريد. في الصباح غادرت النزل، وأشبيلية تستيقظ لتوها، النادلات يضعن الكراسي على الأرصفة في المقاهي، والموظفون عجلون في طريقهم إلى العمل، والبنوك لم تفتح بعد. أسبانيا معبأة بأسماء القديسين والقديسات: تحملها المباني، والمطاعم، والساحات، فالكاثوليكية في زهو قوتها بداية من عصر النهضة جعلت منهم المثل الأعلى للرعية. وصلت إلى الكاتدرائية في العاشرة والنصف، ودلفت من بوابتها الكبرى، فإذا بي أمام قاعة يقام فيها قدّاس. انزويت جالسا مع جماعة من الشيوخ والعجائز، وهم يرددون"آمين"أمام قس عجوز. بدا لي الطقس مدنيا أكثر مما هو ديني، فالألوان الزاهية لملابس الحضور، والاختلاط، وتناوب الخروج والدخول، كل ذلك دفع بالمظهر الديني إلى الوراء على الرغم من أن القداس في أكبر كاتدرائية في المدينة. ذهب بصري إلى الأيقونة في الواجهة، والثريات الكبيرة المعلقة، والنوافذ الطولية المزججة بألوان داكنة، والشموع، والمؤمنين يحملون كتيبات صغيرة يتلون صلواتهم وأدعيتهم في سلام بدا لي مناقضا لما كانت تمارسه الكاثوليكية من عنف في القرون الوسطى في أوربا، وفي أميركا الوسطى والجنوبية منذ القرن الخامس عشر، وقد رسمتُ صورة مفصلة لذلك في كتابي"المركزية الغربية". غادرتُ القداس لأدخل الفناء الواسع للكنيسة، ثم أروقتها المثيرة للعجب فبدت لي أنها تفوق كاتدرائية غرناطة ضخامة ومهابة، وتكشف أن ثروات الكنيسة ضخمة جداً، فباسم الكنيسة كانت تنهب المستعمرات.
على أن الشيء الذي استثار إعجابي هو المنارة السامقة التي دُمجتْ في الكنيسة، وأصبحت جزءاً منها. حوفظ على المنارة الإسلامية، وأكمل أعلاها ببناء كنسي يحمل الأجراس، ووضعت تماثيل القديسين على حافات سطحها، وفي أسفلها كتب بالعربية والأسبانية النص الآتي"أمر الخليفة أبو يعقوب يوسف عريفَه أحمد بن باسو بتشييد هذه الصومعة في 13من صفر عام580 هـ"26مايه1184م"فتم بنائها(= هكذا) علي الغماري في ربيع الآخر من عام593هـ"19مارس1197"من خلال خلافة أبي يوسف المنصور، فجدّد المهندس فرنان رويث هذه الصومعة، وزاد في أعلاها قبة الأجراس في عام1568فنقشت هذه الكتابة في عام1984م تمجيداً للذكرى المئوية الثامنة لإنشاء هذا المنار العجيب."وهذا يعني أنها بنيت في آخر سنة من خلافة أبي يعقوب يوسف الأول، ثالث خلفاء الموحدين.
والخيرالدا نصب جرى تركيبه على منارة المسجد تعويضا عن التفاحات الذهبية التي نصبها العرب فوق المنارة التي كان ارتفاعها96م، وتتكون من طوابق كثيرة، وفي الأخير منها، نصبت ثلاث تفاحات كبيرة وواحدة صغيرة مغلفة بالذهب بوزن ستة آلاف مثقال، قام بصنعها وأشرف على نصبها أبو الليث الصقلي، ثم تحولت المنارة بعد سقوط أشبيلية عام 1248إلى برج للكنيسة. وفي عام 1355ضرب المدينة زلزال عنيف أدى الى سقوط التفاحات، فقرر الأسبان تعويضها بنصب آخر من النحاس هو"الخيرالديو"الذي يبلغ وزنه 1500كيلوغرام، وهو عبارة عن تمثال مع شارة دوارة تحركها الرياح، صنعها الفنان بارتولومي مورين عام1568. منار عجيب، تتلاشى بإزائه كثير من الأعاجيب، يتكوّن من أربع وثلاثين طبقة، ارتقيته صعدا على الأقدام، وحينما وصلت الطبقة الثالثة والعشرين سجّلت ذكرى على جدار إحدى النوافذ باسمي وتاريخ الزيارة. تفحصت البناء المتكوّن من صرح خارجي بعرض يزيد على مترين، وهو مربع الشكل فيه نوافذ تكشف سُمك البناء، ثم ممر بعرض مترين أيضاً للصعود سيراً دون أدراج، ثم البناء في الوسط وهو صلب المنارة، وبين طابق وآخر، وضعت في الوسط الآلات التي استعملت في البناء، وحينما شارفت القمة تنفست الصعداء، فإذا بالمشهد المذهل لأشبيلية من الأعلى وهي ترتمي على ضفة الوادي الكبير. تأملت الأجراس المائلة المعلقة أعلى المنارة، أربعة منها يزيد وزنها على طن، ونحو ستة أو سبعة أخرى معلقة إلى جوارها. تمنيت أن أراها تقرع. نظرت إلى الساعة فإذا بنا في منتصف النهار، فسألت جارا لي إن كان من المفترض أن تقرع في هذا الوقت، وقبل أن أكمل الجملة قرعت بشدّة ثلاث مرات فوق رأسي على ارتفاع ذراعين، فتحقق ما كنت انتظره منذ زمن طويل، دخت بضجة الأجراس، ورنينها يتردد في أرجاء أشبيلية، فكأن رأسي طبل من نحاس. وكمن وقع على كنز فاختطفه هاربا، هبطت جريا يدفعني انحدار الممر إلى باحة الكنيسة. اخترقت"سانتا كروثا"إلى"سان بنيتو" فحملت حقيبتي، واتجهت إلى"سانتا كوستا".
غادرت بالقطار السريع"آبه"باتجاه مدريد. سفر يفوق سفر الطائرة روعة، ويقارب سرعتها. بعد أن تشبع نظري بهضاب الأندلس، وجبالها، وغاباتها، وأنا اخترقها صعدا إلى الشمال لذت بـ"الدون كيخوته"أقرأ مغامراته التي لا تمل. وصلت مدريد عصرا، وسكنت في نزل ذي أحجار رخامية، وهاتفت محسن الرملي، فالتقينا في مقهى قرب الفندق، واستعدنا جزءا من ذكرياتي عن أخيه حسن مطلك صديقي الذي أعدم في عام 1990. زرنا المنتزه الرئيس في مدريد وكان خاصاً بعلية القوم في القرون الماضية، وصار الآن مرتعا لأصحاب النزوات. وشربنا القهوة في مقهى"خيخون"حيث ظهرت الحداثة الشعرية الأسبانية. وفي الطريق، ونحن في قلب المدينة، طوقتنا عصبة من المتسولات البوسنيّات الصغيرات، فنهرهن الرملي صائحا، فتناثرن مبتعدات. أصرّ أن يرافقني إلى شقته، فانتزع حقيبتي من الفندق، وأخذنا المترو إلى بيته، فقد كان تزوج أسبانية وأقام معها، وأخلى شقته القديمة لصديقه عبد الهادي سعدون. أمضيت النهار اللاحق بكامله مع الأخير، فزرنا متحف الملكة صوفيا للفن الحديث، حيث لوحات بيكاسو، ودالي، وميرو، ثم غونثاليث، ودومينغيث، وغريس، وبونويل. وقفت أمام الجرنيكا التي تحرسها هيفاء مشرقة البشرة بجدائل غجرية، وتتبعت تخطيطاتها الأولية قبل أن يقوم بيكاسو بإدراجها في لوحته الكبيرة الملصقة على جدار مرتفع.
قبيل وصولي إلى أسبانيا كنت قرأت كتاب"فرانسوا جيلو"الأخّاذ"حياتي مع بيكاسو"وهو مذكرات صديقته الشابة التي فضحت على نحو منقطع النظير الشخصية المركّبة للفنان في أهم مراحل حياته، فالفرنسية ذات الخلفيات التقوية المتأففة، أسقطت عليه كل مساوئ الأسبان، لم تنظر إليه شريكا بل أسبانيا، وطبقا لمنظورها كفرنسية يظهر القرين سيئا، فأخلاقياته المتوسطية الجنوبية تتنامى في التضخيم خلال صفحات الكتاب، وهو الشر بعينه: الأنانية، الغرور، الطيش، الخداع، النهم، تعمد السوء، إذلال الآخرين ومسخهم. سلسلة متضافرة من صفات السوء تتصاعد في حبكة بارعة الدقة تمسخ بيكاسو، وتحطم أسطورته. وضع مجد بيكاسو وقيمته الفنية بمواجهة رؤية أخلاقية لامرأة احتكمت إلى ضميرها الديني في تقويم، وإعادة تركيب، شخصية نشأت في منأى عن هذه المعايير. ولتعميق هذا الحكم تتواتر منذ البداية إلى النهاية فكرة الوفاء الأنثوي الفرنسي بمواجهة النكران الذكوري الأسباني، فمنظورها ينهض على تجميع ملاحظات عميقة، ولكنها متناثرة، تفضي شيئا فشيئا إلى تقويض أية قيمة لشخصية بيكاسو.
وانتقلت إلى سلفادور دالي الذي كنت مهووساً به أيام الشباب. لوحاته رائعة، ورسوماته غريبة، لم أجد أحب اللوحات"الذكرى الدبقة"التي احتفظت بصورة منها جوار سريري في النصف الثاني من السبعينيات حينما كنت في جامعة البصرة، وهي تصور سيلان الزمن. شغفت باللوحة آنذاك لأنني وضعت نفسي في عبثية مضادة لقيمة الزمن الذي وجدت دالي يذيبه بصورة الساعة المائعة، فلذت بها أحتمي من جهلي في تفسير فلسفي لأحاسيسي متحاشيا مواجهة الحقائق. أما خوان ميرو فرموزه مغلقة، والخطوط العريضة على خلفية بيضاء ظلت عصية عليّ إلى النهاية، ولكن الأصابع المتدلية، والوجوه الضائعة، وغياب التناسب، وتحطيم المنظور التقليدي، شدّني إليه، وبعد سنتين انتقيت إحدى لوحاته لتكون غلافا لأحد كتبي. طفنا بالمتحف إلى أن أصبنا بالإرهاق، ثم اتجهنا إلى وسط المدينة، تناولنا الغداء في مطعم تركي. وعدنا في الرابعة، وقد ادّخرتُ طاقتي لزيارة متحف"البرادو" الذي بكرت في الصباح إليه وحيدا، فأمضيت خمس ساعات في مشاهدة لوحات روبنز، وفيلاسكز. أما غويا فقد شعت لوحاته في قاعات واسعة تزاحم حولها الزائرون.
والبرادو مبنى تقليدي كبير ذو سلالم رخامية متآكلة، دخلته مسكونا بلحظة ترقّب لرؤية أعمال ممهورة بالخلود والألق، وهي الدهشة نفسها التي لازمت دخولي في متحف اللوفر، والمتحف البريطاني، ومتحف أمستردام، فالبرادو - كاللوفر- خزانة عريقة لمدارس الفن الكلاسيكي. بدأت فكرته تلوح في الأفق في عهد كارلوس الثالث، وسعى جوزيف بونابرت، لتحقيق الفكرة، لكنه أصبح حقيقة في عهد فرناندو السابع بتأثير من زوجته الثانية ماريا إيزابيل التي توفيت قبل افتتاحه عام1819وإبان الحرب الأهلية في ثلاثينات القرن العشرين، عهد لبيكاسو بأمانته، ولكن الأحداث رسمت خطرا محدقا بمقتنياته، فأغلق، بعد أن نقلت محتوياته إلى فالينسيا، ثم إلى كتالونيا، قبل أن تودع في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث عادت إليه بعد الحرب. وفيه وجدت الفخامة الكلاسيكية لفنون عصر النهضة، حيث المطابقة شبه الكاملة بين الرسم وموضوعه، فالفن مقيد بالأمانة والدقة، والتمثيل رهين المماثلة، فالصورة البصرية شديدة التعبير عن الصورة الذهنية، ولم تخرّب بعدُ الصلة بين الأصل وكيفية إنتاجه، فذلك من مكاسب الحداثة. وجدت لوحات ضخمة تحتل صدر قاعة بكاملها، لفتتني معايير الجماليات الأنثوية، فالأجساد مملوءة، والجلود ثخينة ومطوية، والأثداء ضخمة نافرة، والأرداف شبه مترهلة، والرجال إما فسوقة قساة بقبعات عريضة، أو محاربون على خيول هائجة يشهرون سيوفا مستقيمة يطاردون المجهول.
ثم انطلقت بالقطار بعد أيام إلى طليطلة، وفيما كنت أسأل عن الكاتدرائية، أجابني شخص بالمغربية الدارجة إنها بالاتجاه الذاهب إليه برفقة زوجته وصديق أسباني، فدعاني لمرافقتهم. دليلنا المرح يدعى لويس، وقام المغربي بالترجمة من الأسبانية وإليها، لويس، وهو أستاذ جامعي من طليطلة، كان مرحاً ومتهكماً، وقادنا إلى الكاتدرائية، فبدا لي وكأنه يهمّ بالركض، ويريد شرح كلّ شيء يراه. أشار إلى مستطيلات نحاسية صقيلة بفعل الأحذية على أرض الكنيسة، وأخبرنا أنها قبور لرهبان، ثم أشار إلى السقف حيث توجد طرابيش معلقة، وقال إن أهل طليطلة يعتقدون أن هؤلاء الرهبان سيدخلون الجنة حين تسقط الطرابيش، لكنها ظلت معلقة مذ وضعت، والرهبان في انتظار وعد الرب. وصل بنا إلى قطعة نحاس أخرى، فأخبرنا أن قسا يرقد تحتها، وقد أوصى أن يكتب عليه"لا يوجد هنا إلا غبار". زرنا غرفة الذهب والمجوهرات، فظهر الثراء الكنسي مرة أخرى، وغادرنا نخترق الأزقة الضيقة المرصوفة بالحصى. أوفقنا لويس عند زاوية علّقت فيها صورة السيدة العذراء في صندوق زجاجي، حيث كومة من الدبابيس والإبر، وأنبأنا أن فتاة تعشق جندياً كانت تأتي لانتظاره في هذه الزاوية، وكان النوم يأخذها أحيانا، فتأخذ إبرة تشكك أصبعها كيلا تنام، وعاد الجندي من الحرب وتزوجا. وبنات طليطلة يأتين ويشكنّ أصابعهن بالإبر بأمل التزوج ممن يعشقن، وهذه الكومة من تلك الإبر.
مررنا بمسجد صغير يجري ترميمه، شبه ضائع بين البنايات الشاهقة. فأشار لويس إلى صخرة بيضاء أمامه، وقال إن المسيحيين كانت لهم كنيسة في المكان، ولما جاء المسلمون نزل المسيح وحفر حفرة، وأشعل سراجاً، ووضعه فيها، ولما طُرد المسلمون من طليطلة، بعد قرون، جاءت الجيوش المسيحية، فحرنَ حصان القائد في مكانه، فأمر بأن يحفر المكان فإذا بالسراج مازال مضاء. افترقت عنهم، واتجهت إلى قلب المدينة القديمة، إلى الحي اليهودي"الخدرية"الذي يماثل الحي نفسه في قرطبة. وعلى الرغم من أن أشبيلية، وقرطبة، وغرناطة، وطليطلة، بدت متشابهة إلى حد كبير، بالنسبة لي، إلا أن الأخيرة ظهرت وأبهى، وأعظم، إنها تقع على جبل أشبه بهضبة عظيمة مشجرة، وتترامي البيوت المتكونة من عدة طبقات على السفوح، تفصل بينها شوارع ضيقة، ومعظمها لا يسع لمرور السيارات، وهي من مدن المنطقة الوسطى. نضرة، عريقة، نظيفة، ومتحف عمراني كبير، تتنفس معاً عبق الماضي والحاضر في نوع من التوافق الخصب، فطرز القرون الوسطى الإسلامية لهذه المدن، وأزقتها الضيقة، لم تحل دون شيوع الروح العصرية فيها حيث الحانات الجميلة، والمطاعم الفخمة، ومحلات الأزياء الحديثة، فضلاً عن المصنوعات التقليدية، وفي مقدمتها السيوف التي كانت مشهورة في كامل أرجاء أسبانيا.
ثم انحدرت إلى الطرف الآخر من المدينة لتصفّح المنساب بهدوء بين ضفاف طينية، فإذا بي أمام منزل"غريكو"الرسام الذي عرفني إليه كازانتزاكي في سيرته الأخاذة"تقرير إلى غريكو" وقال عنه إنه "معجون من التربة الكريتية" فهما يتقاسمان دم سلالة واحدة. بوابة المنزل الخشبية مشققة، والبناء يعود إلى ما قبل أربعة قرون. وعدت إلى محطة القطار وقد بنيت على طراز المدينة القديمة، وتذكر بالمحطات التي تظهر في أفلام رعاة البقر. ويمكن توقع ظهور"كاوبوي"على حصانة من السهل المجاور. من هذا الجانب من السهل انطلق"دون كيخوته دي لا مانتشا" في رحلته الخيالية المجنونة، فإقليم المانتشا حيث تدور مغامرات الفارس النبيل متصل بطليطلة. أمضيت اليوم اللاحق في مدريد، زرت برج بيكاسو، وتمثال كولومبس الذي بني في عام 1885وقصدت النصب الضخم المجاور الذي يصور الفتوح الأسبانية للعالم الجديد، وثمة نصوص محفورة على الألواح الحجرية الكبيرة، تحتفي بالمجد الأسباني في فتح العالم، واتجهت إلى متحف للشمع. أول قاعاته خاصة بالعرب المسلمين، وارتحت طوال الظهيرة في مقهى خيخون.
ذهبتُ عصر اليوم التالي إلى"ساحة الثيران". بني المدرج المهيب، المناظر لملعب كرة القدم، في عام 1929، وشهد حضور شخصيات عظيمة. وهو البؤرة الجاذبة لمحبّي مصارعة الثيران في أسبانيا والعالم. أروقته الواسعة، وسلالمه الحجرية، ونوافذه الكبيرة، والمقاعد الخشبية العتيقة، ثم شرفته المندفعة في الفضاء، هيأتني لحفلة من عنف، وسرعان ما امتلأ المكان الذي يسع لعشرين ألف متفرج. بدأت المصارعة بجولات ست أو سبع. وتتألف الجولة من مراحل، تنطلق الأولى بدخول المصارع الذي يستفزّ الثور لخمس دقائق من أجل إرهاقه من جماعة من اللاعبين الذين يحتمون خلف مساند من الأسمنت إذا هاجمهم الثور الهائج الذي فوجئ بأنه وسط عالم غريب عنه، ثم يدخل فارسان دُرّع حصاناهما بالجلود الثخينة، وبيد كل منهما رمح طويل، ترافقهما جماعة أخرى من اللاعبين، فيستفزان الثور الذي ينطح درع الحصان، وخلال ذلك يغرز الفارس رمحه في سنامه، ثم يمعن في تمزيق جرحه، وتنتهي الجولة، ليظهر لاعبان يحملان رمحين، يحاول كل منهما غرز رمح في السنام المثخن بالجراح، فتتكاثر الرماح القصيرة التي تمزق السنام، وتظل نابتة في أعلاه، أو متدلية، فتعمّق الأذى، وينسحب هؤلاء ليظهر المصارع الذي يتقصّد إرهاق الثور برايته الحمراء وسيفه، فالحيوان لا يميز بين الألوان، ويهجم على غمامة معتمة أمامه، وكلما تحرك زادت الرماح تمزيقاً فيه.
ويعود المصارع لأخذ سيف طويل، ورفيع، ومستقيم، ويحاول بالخداع أن يجر الثور إلى وسط الدائرة، تحت أنظار جمهور تدفّق هياجه البدائي، فيتحيّن الفرصة لطعنة تناسبه، وبعد أن يترنح الثور تعباً يستغل الفرصة فيغرز سيفه في أعلى السنام الذي كان أحد الفرسان فتحه بالرمح من قبل، فيغرز الرمح فيه إلى أن يبلغ القلب والأحشاء، وكلما اختفى السيف في جسد الثور كانت الضربة موفقة، وتلاقي تشجيعاً هوسيا من المتفرجين الذين انفلت حماسهم الوحشي. وأخيرا يقوم المصارع بأخذ سيف جديد، فيما خصمه يتهاوى مترنحا، مثخنا، فيتخير طعنة في مخه، وهي الضربة القاتلة التي يسقط إثرها صريعاً بعد أن ينغرز السيف في هامته، وإذا ظل يتحرك يتقدم رجل يحمل خنجراً قصيرا فيطعنه طعنات سريعة قاتلة في الرأس خلف القرون إلى أن ينهار صريعا، فيزفر زفرته الأخيرة، والدماء تشخب من فمه ورأسه، وتتقدم خيول يمتطيها فرسان بأزياء ملونة، فيُسحل الثور بالحبال من قرنيه في حركة استعراضية كرنفالية دائرية إلى الخارج لتبدأ جولة جديدة.
ترجع هذه اللعبة إلى حقبة مغرقة في القدم، ويرجّح أنها عرفت منذ نحو ستة آلاف سنة، وثبت شيوعها في عهد يوليوس قيصر أحد أشهر أباطرة الدولة الرومانية، ويورد لسان الدين بن الخطيب في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي، وهو من غرناطة، وصفا بارعا لها، وقد كانت الكلاب تقوم مقام اللاعبين المُنهكين للثور" يُطلق الثور، أو بقر الوحش، ثم تطلق عليه كلاب اللان المتوحشة، فتأخذ في نهش جسمه وأذنيه، وتتعلق بهما كالأقراط، وذلك تمهيدا للقاء المصارع الذي يكون فارسا مغوارا يصارع الثور، وهو على فرسه، ثم يقتله في النهاية برمحه" وتاريخ مصارعة الثيران غامض، وملتو، وأقرب إلى أن يكون، في أصوله، طقسا للقتل. ومن المستحيل كتابة تاريخ موضوعي لأي فعل معمّد بالدم. وتمارس المصارعة بنسب متباينة في أسبانيا، والبرتغال، والمكسيك، وفرنسا، وكولومبيا، والأكوادور، وفنزويلا، واستوحاها رسامون كبار منهم غويا، وبيكاسو الذي كان مغرما بها.
عرفت مصارعة الثيران تطورات كثيرة، فالراية الحمراء التي يضلل بها المصارع الثور أضيفت في عام 1725، ويُسمى المصارع matador أما الفارسان اللذان يخزان الثور بالرماح غرض إنهاكه وإغضابه، فكل منهما يسمى Picador. وطول السيف المستخدم في الطعن هو متر واحد، وقد صُمِّم بحيث يخترق قلب الحيوان، وأغلب المصارعين لا يوفّقون في معرفة مكان القلب، فيمزقون رئتي الثور فلا يموت فورا، وإنما تتلاشى حياته بسبب تمزيق أعضائه الحيوية، ويصبح احتضاره عذابا مضاعفا. وقد تنتهي اللعبة بطقس انتصار رمزي يقطع فيه المصارع أذن الثور وذيله، ويستعرضهما أمام الجمهور، ويحتفظ بهما ذكرى مدى الحياة، وفي حال ما أدى الثور عرضًا مثيرا، وتميز بالمطاولة والشراسة، فيُكرم بأن يُسحل في عرض أمام الحاضرين بخيول أعدت لهذا الغرض. ويمثل الأميركيون أعلى نسبة في حضور هذه الألعاب بين الآخرين، وقد جلست جواري أميركية شقراء طوال العرض، كانت تلتذ منفعلة بالمنعطفات المأساوية الحاسمة لمصائر الثيران، وتصدر صفيرا في تشجيع المصارعين، وتخبط المقعد بيديها ومؤخرتها حينما يشنّفون قاماتهم بكبرياء أمام كدس بشري شحنة هوس الانفعال. ومعلوم أن همنغواي كان من أشهر محبي هذه اللعبة بين الكتاب.
وبدأت مصارعة الثيران تواجه بمعارضة شرسة من دعاة الرفق بالحيوان، وكشفت أسرار كثيرة حول الطريقة التي تربى الثيران بها، إذ يحبس الثور أربعا وعشرين ساعة في غرفة مظلمة وضيقة قبل الموعد، فلا يتمكن من رؤية شيء، ولا يسمح له بالحركة، ثم يطلق فجأة وسط الضوء والصياح، فيصاب بالحيرة، وتشلّه المفاجأة، فيما تمعن الرماح في طعنه. وهذه الحال تظهر الثور بمظهر عدواني، والحقيقة فقد دهمه ذهول، واضطراب. وتُخفى عن الجمهور كل هذه المقدمات. وليس من الغريب أن نجد تنويعا لهذه اللعبة في بقايا المستعمرات الأسبانية والبرتغالية في أميركا اللاتينية وآسيا، بل في بلاد الخليج العربي حيث افتتح البرتغاليون الحقبة الاستعمارية في القرن الخامس عشر، ففي الفجيرة، على الساحل الشرقي من دولة الإمارات، تمارس مصارعة الثيران، لكنها بين الثيران فقط، وتقام بعد صلاة العصر من كل جمعة في الأصياف غالبا. والأهالي يعدونها من تراث أجدادهم. وتجري عليها رهانات بين الحاضرين، والمنظّم الذي يقوم بالتعليق والتشجيع وإثارة الحيوانات يسمى"مثير الفتن".
وهذه اللعبة دموية، وشنيعة، لأنها ترتكز على المفارقة غير الأخلاقية بين القوة البريئة والغدر المريع، فالثور الذي رُبِّي في مكان منعزل يفاجأ حينما يُدفع به وسط آلاف الناس الهائجين، وما دام يمتلك القوة، فاللاعبون يخادعونه، ويحتمون من اندفاعاته خلف حواجز الأسمنت، فيزداد تشتتا لأن الهجمات تأتيه من الجهات كافة. ويحاول اللاعبون ويبلغ عددهم أكثر من عشرة بين مصارع، وفارس، ومساعد، ورامح، إنهاك الثور الذي لا يعرف من أين يدهمه الخطر. تبدأ الطعنات تنهال عليه يرافقها استفزاز، وكل حركة منه تضاعف تمزيق جسده بالرماح المنغرزة في سنامه، فيشترك هو وخصومه في التنكيل بنفسه، وهذا يجافي أي مبدأ ممكن لأي منازلة، فكيف بلعبة!! وكلما خارتْ قواه تضاعف غدر خصومه، ولكن الأمر الملفت للنظر هو مشاركة الجمهور المرضيّة في تشجيع المصارع لإلحاق أقصى درجات الأذى بالحيوان الذي كلما مرّ الوقت أصبح خصماً لدوداً للمصارع، والجمهور على حد سواء.
وحينما تأتي ضربة القلب القاتلة، ثم غرزة الدماغ التي يخرّ بعدها الثور صريعا، يبلغ هياج المشجعين ذروته، فتخيّم نشوة العنف الأعمى في الملعب كله، فبدل أن تحل الشفقة على الضحية تندلع الحماسة الانتقامية المتصاعدة ضدها. وطوال الجولات الست أو السبع كنتُ حائراً في تفسير هذه الروح العدائية تجاه براءة مطلقة. ولم يبق أمامي سوى تفسير ثقافي، وهو أن الثور يمثل رمزاً شريراً في طيات اللاوعي الجمعي للأسبان، فوجدتني انظر باشمئزاز لا يمكن طمره إلى بشر تتدافع مشاعرهم العدوانية باطراد ضد الحيوان الذي ينفث من فمه مزيجاً من الدم والزَبد، وهو يرغي في مشهد مروع، فكأن الجمهور يتشفّى من كائن ارتسمت نهايته، وأصبح التخلّي عنه شعورا يستبطن الرغبات الدفينة التي يمثلها الانفضاض عن القوي لحظة انهياره، كما يقع في حالات سقوط الطغاة حيث أول من يتوارى مناصروهم. فهل يتماهى الجمهور مع بطولة زائفة يمثلها المصارع الذي وصل إلى قتل الخصم عبر سلسة مكشوفة من الخدع والمساعدين؟ ولماذا يضج الآلاف بصيحات الاهتياج كلما ترنح الثور الذي يبدو سلوكه غاية في الاستقامة والبراءة الغبية؟ ولماذا يصيحون هاتفين"أُولي"بصوت واحد، فهل لذلك علاقة بنداء"الله"الموروث عن العرب المسلمين، وقد حرّف اللفظ؟ وهل يتطهّر الجمهور عبر التأييد الواضح للمصارع من خمول أو ذنب أو حينما يترنح الخصم مضرجا بدمائه؟.
نشرت هذه المادة بعد استحصال موافقة كاتبها الصديق العزيز الدكتور عبدالله ابراهيم وقد أهداها للمجلة واصدقائه في كركوك .
د.عبدالله إبراهيم
وصلتُ الباخرة في اللحظات الأخيرة قبل مغادرتها ميناء طنجة المغربي إلى الجزيرة الخضراء في أسبانيا، فاندهشت بأمواج البحر المتوسط تحتضن أمواج المحيط الأطلسي. موجة تعقب أخرى، فأخرى. تجولت في أنحاء السفينة كالمجنون الذي يريد اقتناص اللحظات، واستندت إلى السياج أتأمل جبال المغرب المشجرة تتوارى شيئا فشيئا إلى يميني. لاحظت أكواخا بعيدة، وسنون جبلية جرداء، وكهوفا، ثم غابات كثيفة. أثارتني المياه الداكنة، والسفينة تشقها منسابة فيتناثر الزبد يميناً وشمالاً، وتراءت لي الأندلس من بعيد ذكرى قادمة من عمق الماضي، أو رغبة خاطئة، تلك الأندلس التي توهجت للحظة، ثم سقطت في عتمة النسيان. وصلت الجزيرة في الرابعة عصرا من يوم12/7 /2001 وبعد أن انزلقت بنا الباخرة إلى ميناء يقع بين جبل طارق وطريف، رمتنا على رصيف حديدي صدئ، فانفرط عقدنا كأننا حفنة زبيب تناثر من زكيبة. مررت من نقطة الدخول متعجلا، لا أرى إلا ما أفكر فيه، ولم أعط نفسي حق اكتشاف الأشياء، فختمت جواز سفري فتاة متثائبة، وأخذت الحافلة إلى غرناطة.
لم أتمهّل لمعرفة الأرض التي وقّّع عليها العرب بخطواتهم الأولى كأنني أفرّ من حدث غامض يتأرجح بين المفخرة والعار، فلم أحسم تأويلي للحظة وصولهم إلى أرض أخرى، والبقاء فيها، لكن مروري الاستكشافي بالأندلس، ورؤيتي لرفعة الأثر، ترك معنى ايجابيا لقضية الأندلس في نفسي، وتشبّعت بالقرون الثمانية التي أقامت صرح تجربة ندر مثيلها في تاريخ العرب. وحينما وصلت كنت فرغت لتوّي من تدريس جامعي لأشعار الغزال، وابن خفاجة، وحفصة الركونية، وولادة بنت المستكفي، ونزهون الغرناطية، ومهجة القرطبية، وابن زيدون، فالأندلس تتّقد في مخيلتي ومضة جمال مبهرة. مررت بـ"ماربيا"ثم"ملقا"بموازاة الشاطئ، وانعطفت ناحية غرناطة في عمق اليابسة إلى الشمال جوار جبل عظيم. فتح المدينة طارق بن زياد في مطلع الثلث الأخير من القرن السابع الميلادي، وقد استعادها الملك فرناندو في عام 1492.
حططتُ رحلي بغرناطة في الثامنة، لست غازيا، ولكنني متشوّف لمعرفة بقايا مجد غابر. واتجهت أول صباح اليوم التالي إلى"القصر الحمراء"فانتظمت في طابور طويل للحصول على تذكرة الدخول. وبدأت الدهشة تتصاعد في داخلي، وأنا في الممر المؤدّي إلى قصور شادها بُناة ضربهم الجمال في أعماقهم. اتجهت شمالا، وعبرت جسراً صغيراً، فانزلقت إلى عالم مبهر: باقة من المباني العريقة، والقصور المترابطة التي يفضي بعضها إلى بعض. تأتي الحمراء من الماضي لتجمع عشرات اللغات، والأجناس، والثقافات. وأمواج السائحين تتداخل فيما بينها، متجمّعة حول الأدلّة يشرحون كل شيء، ويستحضرون الماضي. وتتردد كلمات"العرب"و"المسلمون"في أرجاء تذكّر بأنهم كانوا هنا وذهبوا إلى غير رجعة.
يصغي الأميركيون إلى الدليل، ويبدون دهشة حينما يخبرهم إن كل ما يرون قد شيّد قبل اكتشاف بلادهم، فتتردد شهقاتهم في الأروقة المضاءة بالشمس عبر النوافذ المزججة، والعجائز منهم يشعرون بحاجة إلى التاريخ فيما يظن الشباب بأن التاريخ بدأ بهم، ولا حاجة لهم بذاكرة. وذبت بفوج أصغى، وأتعرّف، وتشرد بي الذاكرة بعيدا إلى الماضي، فأبدو نافرا كمن ينتمي ولا ينتمي إلى هذه اللحظة، ثم فارقتهم في مدخل قصر الناصر، وارتقيت سلماً لأجد نفسي على مقربة من منارة صارت كنيسة يعلوها جرس ضخم، فتأملت فيها طويلاً، وطفت بالقصر الدائري، وتفحصت المنمنات، والأروقة المفتوحة، ودهشت حينما انتقلت إلى الحدائق حيث الأشجار، والنافورات، والممرات المرصوفة بحصى تاريخية، وتصوّرت حال بني الأحمر، وفهمت بعمق المقولة التي طالما قرأتها، حينما خاطبت آخرَ ملوك بني الأحمر أمَُه" إبك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال"ففي هذا الفضاء الخلاب لا يشعر المرء بأنه يملك ثروة، إنما هو جزء من شيء نادر واستثنائي.
لا يمكن فهم الحمراء على أنها قصر، فهي مزيج من الروح الخلاقة والفن العريق، والقوة الجميلة، واللطف الشفاف. ولم أحس بأنها مكان للسلطة، فالجمال قهر كل شيء، شعرت في زيارتي للآثار الأخرى بأنها أماكن للقوة والعنف، كما وقع لي في قلعة"مون سان ميشيل" في النورماندي، وقصر"فرساي"قرب باريس، وقلعة أدنبره في أسكتلندا، وقلعة"الشقيف"في جنوب لبنان، وقلعة"الربض"في عجلون بالأردن، لكن إحساسي بالجمال في الحمراء ذهب بي إلى أنها كانت خلاصة لذوق سام تغلّب على كل شيء. عرفت الحمراء الرفعة والذل، وشهدت أمواج الدهر لقرون طويلة. في البدء بنيت قلعة حصينة للزعيم البربري ابن حبوس، اختارها على مرتفع من الأرض، ليحدّق دائما في غرناطة المرتمية في الوادي، وأحاطها بسور محكم، يحتمي به من صروف الدهر، وعلى الرغم من ذلك انتزعها بنو الأحمر، وأحالوها جنة طوال عهدهم، وحينما خرج آخرهم، أبو عبدالله الصغير، حمل معه رُفات أسلافه ليردم بئر الذكرى، فآل المكان قصرا للملك الأسباني الذي ورث المدينة، وحاز على صكّ استسلامها، فعبثتْ يد التعصب في أرجائها، كما يحدث في كل واقعة حينما يرث دين دينا آخر، فحلّت الكنائس فيها محلّ المساجد، وكشطت الزخارف العريقة، وألقيت في الوادي المجاور، ونُقشتْ محلها زخارف رومانية. ولما رحل ملوك الأسبان إلى مدريد أصبحت الحمراء ثكنة، وما لبثت أن هُجرت إثر انفجار مخازن البارود فيها، فأضحت مهجعا للغجر، وقطّاع الطرق.
وحينما اقتحم نابوليون أسبانيا مطلع القرن التاسع عشر، ونصّب أخاه ملكا عليها، إتّخذ منها جيشه حامية منيعة. وحيكت أساطير كثيرة حول الحمراء، أوردها"أرفنج"في كتابه عنها إثر زيارته لها نحو عام1830، ولم يعد الاعتبار لهذا الأثر المعماري المترف إلا في القرن العشرين، فأصبح أهم معالم الأندلس الأسبانية. أمضيت ساعات خمس في لذة مدهشة، ولما قادني الممر المشجر إلى الخارج كنت بدأتُ أفهم على نحو ما معنى بأن تكون للحياة قيمة، وأخيراً طلبت إلى مرشدة أسبانية أن تصوّرني عند المدخل، شابة في العشرين، شكرتها، وقلت مازحا إن كانت تعرف أن أجدادي هم الذين بنوا هذا المكان. صعقتْ، ودهشتْ، فالعرب بالنسبة لها كائنات موجودة في التاريخ فقط، ويذكرون كجزء من ماضي أسبانيا. عظمة التاريخ غادرة، وعبء يصعب حمله عبر الزمن. عدت إلى مركز المدينة، ثم صعدت جوار الوادي في الجهة المقابلة إلى "ساكرومونته".
فيما توجهت إلى قرطبة بدأت استعيد طوال الطريق غرناطة مرة أخرى. فقد أمضيت اثنتي عشرة متواصلة في التعرّف إليها بعد زيارة القصر الحمراء، فمنذ الرابعة عصرا إلى الرابعة فجرا أتيت على أهم معالم المدينة. إذ زارني صديق فطلبت أن نتوجه إلى الكاتدرائية العظمى، وهي بناء فخم علّقت على جدرانه لوحات أصلية لـ"غويا"و"فيلاسكس"وآخرين، وبدا المسيح مثيراً للشفقة أكثر من الرحمة، فالرموز المسيحية تميل لإبداء الضعف، واستدرار العطف، لكن المفاجأة كانت في القاعة الكبرى ذات الأعمدة الشاهقة، والأقواس القوطية، فبناؤها مركّب، ومثير للرهبة. دخلنا المتحف الصغير المجاور الذي يخلد أعمال الملكين الكاثوليكيين"إيزابيل"و"فرناندو"وتفحصنا هدايا ذهبية وفضية، منها منحوتات لـ"كانو"تتناثر في أماكن كثيرة، إحداها لرأس"يوحنا المعمدان" أنجزت في منتصف القرن السابع عشر، وأثارني سجل كبير باللاتينية خاص بأعمال الكنيسة، ومصروفاتها المالية للفترة1510-1522 ويذكر بمخطوطات العصور الوسطى.
غادرنا الكنسية بعد ساعتين، فتجولنا في الأحياء المجاورة: المدرسة العربية، ثم القيصرية التجارية التي كانت إسطبلا للخيل، وشربنا قهوة، ثم مضينا إلى البوابة الملكية التي دخلت منها القوات الأسبانية حيث استسلم أخر ملوك بني الأحمر، وفي هذه الساحة كان قسيس غرناطة يأمر بقتل بقايا المسلمين إذا رفضوا الانخراط في النصرانية. مررنا بضفاف نهر"الشينيل"الذي يجري تحت المدينة، وقصدنا الحي العربي حيث يذكّر كل شيء بالعرب: الشاي، والموسيقى، والمعمار، فارتحنا لساعة، ويممنا شطر"البايثين"وهو الاسم العربي لحي"البزازين"القديم، ووصلنا إلى معبد القديس"نيقولا"إذ تنبثق منه للرائي القصور الحمراء خلف الوادي، ويظهر قصر كارلوس الدائري، وإلى اليمين"جنة العريف"وقد سطعت المباني تحت الأضواء المبهرة. اغتسلنا، وشربنا الماء من بئر عربية قديمة تتدفق مياهها من صنبورين، ورحنا نخترق الأزقة الضيقة المرصوفة بالحصى ناحية"ساكرومونته"مكان الغجر، وكهوف"الفلامنكو"والطرقات الضيقة. أعلنت الساعة الواحدة ليلاً، وقد بدأت الكهوف تغلق، ولم أحظ برقصة فلامنكو. اتجهنا إلى جزء آخر من الحي العربي حيث مئات الشباب يمرون في شارع ضيق مترنحين، ذهاباً وإيابا، فعثرنا على مطعم مغربي تعمل فيه فتاة صينية، وراقبنا الألفة البدائية لبشر من مختلف الاعراق يمتّعون بعضهم، ويصخبون، ولما غادرنا الحي كان العمال يغسلون الشوارع الضيقة بمياه هادرة كالفيضان. فوصلت فندقي في الرابعة فجراً. تعلّقتُ بغرناطة الغنية بالتاريخ، والبشر، والحياة.
ثم انطلقت سهما منفلتا إلى قرطبة أريد أن أشكّل فكرة عن عالم كنت أعرف عنه قليلاً. فأخذتني حافلةُ حديثة ناحية الشمال الغربي إلى قلب الأندلس، مررنا بكاله، والكوديت، وبابينا، وأسبيخو، ثم قرطبة، وكلما ابتعدنا عن غرناطة الرابضة عند أقدام جبال"سييرا نيفادا"كانت أشجار الزيتون تغطي التلال، وتتكاثر حقول عباد الشمس. فوصلت عصرا، وجررت حقيبتي إلى نُزل"سينيكا"في الحي اليهودي القديم"الخدرية"المجاور لمسجد قرطبة وكاتدرائيتها"المثكيتا". فتحت لي النزل عجوز قصيرة ضاحكة، وأخبرتني بالثمن، ثم قادتني إلى غرفة بيضاء تكاد تندفع شجرة برتقال من نافذتها الوحيدة. استفسرت عن"الفلامنكو"فأخبرتني بحفلة تقام الليلة، واشتريت تذكرة وأنا في النزل.
خرجت أتعرّف إلى المدينة. الحي أبيض، وطرقاته الضيقة مرصوفة بالحصى، وعلى مبعدة مئة متر تنتصب منارة مسجد قرطبة الكبير الذي بناه عبد الرحمن الداخل بعيد وصوله المدينة في عام 755، وتأسيس الحكم الأموي فيها بعد انهياره في دمشق بست سنوات. توجّهتُ إليه عجلاً، فهالني مزيج من الحضارتين الإسلامية والمسيحية، فتداخلت الثقافات فيه: الأعمدة، السقوف، الممرات، والتصميم العام، المنارة إسلامية ولكن اللوحات والهياكل، والمحاريب، مسيحية. وجدت الكنوز الذهبية للكنيسة، والشمعدانات، والنواقيس، والأعمدة التي تذكر بالزيتونة والقرويين، ثم المنارة الشاهقة التي أُزيلت عمامتها الاسلامية، ونصّرت، وعلقت فيها أجراس هائلة. أفعمتُ بروح عمقت فيّ أحاسيس القصر الحمراء.
غادرت المسجد إلى النهر المجاور، وعبرت الجسر إلى الناحية الثانية حيث البرج العربي، إذ استقبلني موظف أعطاني جهازا ناطقا يصف الحضارة العربية في الأندلس: الموسيقى، والعمران، والزراعة، لكن الأمر الذي جذبني على نحو منقطع النظير غرفة الفلاسفة التي تمثل التداخل الثقافي بأجمعه، غرفة فيها من اليمين إلى اليسار: ابن ميمون، ثم ابن رشد، وابن عربي، ثم الفونسو العاشر. مسلمان، ومسيحي، ويهودي. أربعة من كبار رموز الأندلس بأزيائهم القروسطية، وبتماثيل من الشمع الدقيق الصنع. وحينما دخلت كان الحديث لابن رشد، يصل عبر الجهاز، ثم ابن ميمون، وابن عربي، فالفونسو العاشر، وكلهم يعرض موقفه من قضية الحقيقة والشريعة التي كانت من شواغل اللاهوت في عصرهم، فتضاء الأنوار على الشخصية حينما تبدأ في عرض آرائها. لا أعرف لم راقني عرض ابن رشد من بينهم، وحينما ألقيت بحثي عنه في المؤتمر الدولي الذي عقد في القاهرة في ربيع عام 2002 كنت أستعيد ذلك الهيكل الشمعي الذي يجهر بالحقائق العقلية واثقا، والذي جرّ طريدا من مسجد قرطبة، وأُحرقت كتبه، ونُفي إلى مراكش. وجدت مزيجا من العقائد والأعراق في حوار عميق، فأين نحن الآن من هذا التلازم الذي لا سبيل سواه!.
خيّل لي أن ابن رشد وابن عربي أكثر شباباً بين الآخرين، ولم أنس أن ابن عربي كان شاهداً على إعادة جثة ابن رشد من مراكش إلى قرطبة حينما عودلت بتواليفه على دابّة، فأورد في "الفتوحات المكية"قول الناسخ ابن السرّاج"هذا الأمام وهذه أعماله" فقال ابن جُبير الذي حضر ذلك، وكان من خصومه قبل وفاته " نِعم ما نظرت، لا فضّ فوك"وهو القائل حينما كان ابن رشد حيّا"إن تَواليفه تَوالف". في ربيع العام الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي، أُخرجت جثة الفيلسوف من قبرها الذي دفنت فيه، وأُرسلت إلى قرطبة لتوضع في قبر جديد. غادرت القاعة البيضوية وأنا مشبع بحضور أقطاب المدينة، فواصلت صعودي في سلّم البرج إلى أن بلغت سطحه الأعلى، ومن هناك وقعت معظم قرطبة تحت ناظري. تنشقت الهواء القادم عبر السهول المجاورة، ورأيت الجسر القديم بقناطره العربية، والمياه الغرينية الحمراء، والريح تنفث في داخلي لذة الحبور والمتعة، فهبطت، وعبرت الجسر ثانية إلى النزل في الثامنة والنصف. غمرتني سعادة عميقة، فتمدّدتُ قابضا بيدي غصن البرتقال عبر النافذة الخشبية.
وصلتُ محل"الكاردينال"قبيل عرض"الفلامكنو"بدقائق، بعد أن تهت في الأزقة الضيقة والمتقاطعة للمتاهة اليهودية، فوجدت يابانية تشاركني المنضدة التي حجزتها. تجربتي بكرٌ في معرفة هذا الرقص الغجري. ظهرت لي الحركة الأولى سمجة، ومفتعلة، وآلية، للشاب والفتاتين، ولكن عدوى الانسجام المريع سرت إليّ بعد دقائق، حينما اكتشفت أن الفلامنكو يستند إلى الإيقاع بالأرجل، والقوة المحكمة، والانسجام المنضبط، فتناثر تحفظي في الفضاء المفتوح المملوء بالمشاهدين حينما بدأت الرقصة الثانية التي جرتني من برود الملاحظة إلى روح المشاركة الحارة، فانتقل الايقاع إلى دمي. كان رقصاً بارعاً أدّته فتاة ثم اثنتان، فثلاث، وأخيراً خمس برفقة الشاب الأول. لفت انتباهي دفء الإيقاع، ثم حرارته المتصاعدة، والذروات المفعمة بالقوة، وهو رقص مرهق يقوم على الحركة السريعة وضرب الأرض بكعب الحذاء من أجل ضبط الإيقاع، ثم الانتقال السريع، والانحناء، والتقدم، ثم الدوران، والعودة. الفلامنكو ثقافة جسد، وحركة يعبر بها عن جوهر الثقافة الأسبانية التي تبدو لي بشراً وتاريخاً تمتاز بالحيوية.
وفي الصباح انطلقت إلى مدينة الزهراء التي بناها عبد الرحمن الناصر، رأس الجيل السادس من أحفاد صقر قريش، على سفوح جبل العروس بمواجهة قرطبة، خلال حكمه الطويل الذي زاد على نصف قرن، وتوالى أبناؤه على تشييد قصورهم فيها إلى أن انهار ملكهم في نهاية العقد الثالث من القرن الحادي عشر. بدا المكان مهجورا على نقيض الحمراء. تجولت في الأطلال العربية، ولم أشعر باستثارة المنحوتات النقشية فطالما رأيتها، لكن قاعة عبد الرحمن الثالث أعجبتني كثيراً. صمّمتْ الحدائق وكأنها الفضاء المكتمل للقصور، ولكن الدهر غدر بكل شيء، وحيثما يكون ثمة مجد أجد في نفسي إحساساً بالزهو. أمضيت وقت الضحى أتعقّب خطاي في متاهة من خرائب التاريخ كالباحث عن وهم، وعدت ظهرا بالحافلة عبر طريق ضيق معبّد، تناثرت على جانبيه قطعان من البقر والماعز، ولما التفت ظهرت الزهراء لوحة باهتة ارتسمت على صدر الجبل. أرغب في التعرف إلى قرطبة في نهاية الأسبوع، فخلدتُ إلى راحة القيلولة استعداداً لليل. وغادرت غرفتي في الخامسة والنصف. خرجت من المكان المفعم بالتاريخ. ابتعدت عن الخدرية، واتجهت إلى قرطبة الحديثة. الشوارع خالية فاليوم هو الأحد، تجولت بين مبان جميلة، وفي شوارع مرصوفة بالطابوق. مررت بحديقة مزهرة، ونافورة تقذف سلسلة فضية من الماء نحو السماء، ثم عبرت طرقات بدت واسعة إلى شارع رئيس آخر، وعدت من الجهة الثانية، وجلست في الساحة الكبرى حيث النافورات والفارس المسيحي أعلى النصب.
أردت صباحا إلقاء نظرة أخيرة إلى قرطبة، فتوجهت إلى القصر"الكاثار"وسط الحدائق الغناء، وغادرت النزل إلى محطة الحافلات ظهرا باتجاه أشبيلية عاصمة مملكة بني عبّاد. استغرق الطريق ساعتين إلى الغرب، أقمت في نزل"سان بنيتو"جوار المنطقة العتيقة"سانتا كروث"وخرجت في الخامسة أتعرف إلى المدينة التي فتحها موسى بن نصير. زرت الكاتدرائية العظيمة"الخيرالدا"وتوجهت إلى ساحة"نافيو"حيث ارتحت قليلاً، ومررت بشوارع ترشح بالتاريخ والمهابة، رأيت"الأرشيف الهندي"الذي يحتوي وثائق الفتح الأسباني لأميركا الجنوبية، وتذكرت كولومبس الذي زرت تمثاله في قلب غرناطة. مررت بقصر"سان فرناندو"الذي أصبح مكتباً للبريد، الأمر الذي يؤكد تقلّب الأقدار، واتجهت ثانية إلى"سانتا كروث"التي تشبه"الخدرية" لكنها ذات مبان شاهقة. أعشق الأحياء القديمة لمقاومتها الزمن، ولفتنة الشرفات المشرعة على الريح، والنوافذ الزرق، والمقاهي المرمية على الأرصفة الحجرية، والنادلات بالملامح الغجرية. سمراوت البحر المتوسط اللواتي لا يقاومن.
عدتُ إلى النُزل مرهقا، فغطست في نوم عميق قطعة كابوس، إذ وجدتني أعترض قطارا هائجا بجسدي، فاستيقظت ظمئا، ودرت في باحة النزل مترنحا أبحث عن ماء، أعاد الماء القراح روعي، فانتظرت إلى الصباح عبثا زيارة النوم. ولى دونما رجعة، وبقيت في انتظاره وحيدا، تائها، لكنني عازم، وراغب، وقوي، وعارف بما أريد. في الصباح غادرت النزل، وأشبيلية تستيقظ لتوها، النادلات يضعن الكراسي على الأرصفة في المقاهي، والموظفون عجلون في طريقهم إلى العمل، والبنوك لم تفتح بعد. أسبانيا معبأة بأسماء القديسين والقديسات: تحملها المباني، والمطاعم، والساحات، فالكاثوليكية في زهو قوتها بداية من عصر النهضة جعلت منهم المثل الأعلى للرعية. وصلت إلى الكاتدرائية في العاشرة والنصف، ودلفت من بوابتها الكبرى، فإذا بي أمام قاعة يقام فيها قدّاس. انزويت جالسا مع جماعة من الشيوخ والعجائز، وهم يرددون"آمين"أمام قس عجوز. بدا لي الطقس مدنيا أكثر مما هو ديني، فالألوان الزاهية لملابس الحضور، والاختلاط، وتناوب الخروج والدخول، كل ذلك دفع بالمظهر الديني إلى الوراء على الرغم من أن القداس في أكبر كاتدرائية في المدينة. ذهب بصري إلى الأيقونة في الواجهة، والثريات الكبيرة المعلقة، والنوافذ الطولية المزججة بألوان داكنة، والشموع، والمؤمنين يحملون كتيبات صغيرة يتلون صلواتهم وأدعيتهم في سلام بدا لي مناقضا لما كانت تمارسه الكاثوليكية من عنف في القرون الوسطى في أوربا، وفي أميركا الوسطى والجنوبية منذ القرن الخامس عشر، وقد رسمتُ صورة مفصلة لذلك في كتابي"المركزية الغربية". غادرتُ القداس لأدخل الفناء الواسع للكنيسة، ثم أروقتها المثيرة للعجب فبدت لي أنها تفوق كاتدرائية غرناطة ضخامة ومهابة، وتكشف أن ثروات الكنيسة ضخمة جداً، فباسم الكنيسة كانت تنهب المستعمرات.
على أن الشيء الذي استثار إعجابي هو المنارة السامقة التي دُمجتْ في الكنيسة، وأصبحت جزءاً منها. حوفظ على المنارة الإسلامية، وأكمل أعلاها ببناء كنسي يحمل الأجراس، ووضعت تماثيل القديسين على حافات سطحها، وفي أسفلها كتب بالعربية والأسبانية النص الآتي"أمر الخليفة أبو يعقوب يوسف عريفَه أحمد بن باسو بتشييد هذه الصومعة في 13من صفر عام580 هـ"26مايه1184م"فتم بنائها(= هكذا) علي الغماري في ربيع الآخر من عام593هـ"19مارس1197"من خلال خلافة أبي يوسف المنصور، فجدّد المهندس فرنان رويث هذه الصومعة، وزاد في أعلاها قبة الأجراس في عام1568فنقشت هذه الكتابة في عام1984م تمجيداً للذكرى المئوية الثامنة لإنشاء هذا المنار العجيب."وهذا يعني أنها بنيت في آخر سنة من خلافة أبي يعقوب يوسف الأول، ثالث خلفاء الموحدين.
والخيرالدا نصب جرى تركيبه على منارة المسجد تعويضا عن التفاحات الذهبية التي نصبها العرب فوق المنارة التي كان ارتفاعها96م، وتتكون من طوابق كثيرة، وفي الأخير منها، نصبت ثلاث تفاحات كبيرة وواحدة صغيرة مغلفة بالذهب بوزن ستة آلاف مثقال، قام بصنعها وأشرف على نصبها أبو الليث الصقلي، ثم تحولت المنارة بعد سقوط أشبيلية عام 1248إلى برج للكنيسة. وفي عام 1355ضرب المدينة زلزال عنيف أدى الى سقوط التفاحات، فقرر الأسبان تعويضها بنصب آخر من النحاس هو"الخيرالديو"الذي يبلغ وزنه 1500كيلوغرام، وهو عبارة عن تمثال مع شارة دوارة تحركها الرياح، صنعها الفنان بارتولومي مورين عام1568. منار عجيب، تتلاشى بإزائه كثير من الأعاجيب، يتكوّن من أربع وثلاثين طبقة، ارتقيته صعدا على الأقدام، وحينما وصلت الطبقة الثالثة والعشرين سجّلت ذكرى على جدار إحدى النوافذ باسمي وتاريخ الزيارة. تفحصت البناء المتكوّن من صرح خارجي بعرض يزيد على مترين، وهو مربع الشكل فيه نوافذ تكشف سُمك البناء، ثم ممر بعرض مترين أيضاً للصعود سيراً دون أدراج، ثم البناء في الوسط وهو صلب المنارة، وبين طابق وآخر، وضعت في الوسط الآلات التي استعملت في البناء، وحينما شارفت القمة تنفست الصعداء، فإذا بالمشهد المذهل لأشبيلية من الأعلى وهي ترتمي على ضفة الوادي الكبير. تأملت الأجراس المائلة المعلقة أعلى المنارة، أربعة منها يزيد وزنها على طن، ونحو ستة أو سبعة أخرى معلقة إلى جوارها. تمنيت أن أراها تقرع. نظرت إلى الساعة فإذا بنا في منتصف النهار، فسألت جارا لي إن كان من المفترض أن تقرع في هذا الوقت، وقبل أن أكمل الجملة قرعت بشدّة ثلاث مرات فوق رأسي على ارتفاع ذراعين، فتحقق ما كنت انتظره منذ زمن طويل، دخت بضجة الأجراس، ورنينها يتردد في أرجاء أشبيلية، فكأن رأسي طبل من نحاس. وكمن وقع على كنز فاختطفه هاربا، هبطت جريا يدفعني انحدار الممر إلى باحة الكنيسة. اخترقت"سانتا كروثا"إلى"سان بنيتو" فحملت حقيبتي، واتجهت إلى"سانتا كوستا".
غادرت بالقطار السريع"آبه"باتجاه مدريد. سفر يفوق سفر الطائرة روعة، ويقارب سرعتها. بعد أن تشبع نظري بهضاب الأندلس، وجبالها، وغاباتها، وأنا اخترقها صعدا إلى الشمال لذت بـ"الدون كيخوته"أقرأ مغامراته التي لا تمل. وصلت مدريد عصرا، وسكنت في نزل ذي أحجار رخامية، وهاتفت محسن الرملي، فالتقينا في مقهى قرب الفندق، واستعدنا جزءا من ذكرياتي عن أخيه حسن مطلك صديقي الذي أعدم في عام 1990. زرنا المنتزه الرئيس في مدريد وكان خاصاً بعلية القوم في القرون الماضية، وصار الآن مرتعا لأصحاب النزوات. وشربنا القهوة في مقهى"خيخون"حيث ظهرت الحداثة الشعرية الأسبانية. وفي الطريق، ونحن في قلب المدينة، طوقتنا عصبة من المتسولات البوسنيّات الصغيرات، فنهرهن الرملي صائحا، فتناثرن مبتعدات. أصرّ أن يرافقني إلى شقته، فانتزع حقيبتي من الفندق، وأخذنا المترو إلى بيته، فقد كان تزوج أسبانية وأقام معها، وأخلى شقته القديمة لصديقه عبد الهادي سعدون. أمضيت النهار اللاحق بكامله مع الأخير، فزرنا متحف الملكة صوفيا للفن الحديث، حيث لوحات بيكاسو، ودالي، وميرو، ثم غونثاليث، ودومينغيث، وغريس، وبونويل. وقفت أمام الجرنيكا التي تحرسها هيفاء مشرقة البشرة بجدائل غجرية، وتتبعت تخطيطاتها الأولية قبل أن يقوم بيكاسو بإدراجها في لوحته الكبيرة الملصقة على جدار مرتفع.
قبيل وصولي إلى أسبانيا كنت قرأت كتاب"فرانسوا جيلو"الأخّاذ"حياتي مع بيكاسو"وهو مذكرات صديقته الشابة التي فضحت على نحو منقطع النظير الشخصية المركّبة للفنان في أهم مراحل حياته، فالفرنسية ذات الخلفيات التقوية المتأففة، أسقطت عليه كل مساوئ الأسبان، لم تنظر إليه شريكا بل أسبانيا، وطبقا لمنظورها كفرنسية يظهر القرين سيئا، فأخلاقياته المتوسطية الجنوبية تتنامى في التضخيم خلال صفحات الكتاب، وهو الشر بعينه: الأنانية، الغرور، الطيش، الخداع، النهم، تعمد السوء، إذلال الآخرين ومسخهم. سلسلة متضافرة من صفات السوء تتصاعد في حبكة بارعة الدقة تمسخ بيكاسو، وتحطم أسطورته. وضع مجد بيكاسو وقيمته الفنية بمواجهة رؤية أخلاقية لامرأة احتكمت إلى ضميرها الديني في تقويم، وإعادة تركيب، شخصية نشأت في منأى عن هذه المعايير. ولتعميق هذا الحكم تتواتر منذ البداية إلى النهاية فكرة الوفاء الأنثوي الفرنسي بمواجهة النكران الذكوري الأسباني، فمنظورها ينهض على تجميع ملاحظات عميقة، ولكنها متناثرة، تفضي شيئا فشيئا إلى تقويض أية قيمة لشخصية بيكاسو.
وانتقلت إلى سلفادور دالي الذي كنت مهووساً به أيام الشباب. لوحاته رائعة، ورسوماته غريبة، لم أجد أحب اللوحات"الذكرى الدبقة"التي احتفظت بصورة منها جوار سريري في النصف الثاني من السبعينيات حينما كنت في جامعة البصرة، وهي تصور سيلان الزمن. شغفت باللوحة آنذاك لأنني وضعت نفسي في عبثية مضادة لقيمة الزمن الذي وجدت دالي يذيبه بصورة الساعة المائعة، فلذت بها أحتمي من جهلي في تفسير فلسفي لأحاسيسي متحاشيا مواجهة الحقائق. أما خوان ميرو فرموزه مغلقة، والخطوط العريضة على خلفية بيضاء ظلت عصية عليّ إلى النهاية، ولكن الأصابع المتدلية، والوجوه الضائعة، وغياب التناسب، وتحطيم المنظور التقليدي، شدّني إليه، وبعد سنتين انتقيت إحدى لوحاته لتكون غلافا لأحد كتبي. طفنا بالمتحف إلى أن أصبنا بالإرهاق، ثم اتجهنا إلى وسط المدينة، تناولنا الغداء في مطعم تركي. وعدنا في الرابعة، وقد ادّخرتُ طاقتي لزيارة متحف"البرادو" الذي بكرت في الصباح إليه وحيدا، فأمضيت خمس ساعات في مشاهدة لوحات روبنز، وفيلاسكز. أما غويا فقد شعت لوحاته في قاعات واسعة تزاحم حولها الزائرون.
والبرادو مبنى تقليدي كبير ذو سلالم رخامية متآكلة، دخلته مسكونا بلحظة ترقّب لرؤية أعمال ممهورة بالخلود والألق، وهي الدهشة نفسها التي لازمت دخولي في متحف اللوفر، والمتحف البريطاني، ومتحف أمستردام، فالبرادو - كاللوفر- خزانة عريقة لمدارس الفن الكلاسيكي. بدأت فكرته تلوح في الأفق في عهد كارلوس الثالث، وسعى جوزيف بونابرت، لتحقيق الفكرة، لكنه أصبح حقيقة في عهد فرناندو السابع بتأثير من زوجته الثانية ماريا إيزابيل التي توفيت قبل افتتاحه عام1819وإبان الحرب الأهلية في ثلاثينات القرن العشرين، عهد لبيكاسو بأمانته، ولكن الأحداث رسمت خطرا محدقا بمقتنياته، فأغلق، بعد أن نقلت محتوياته إلى فالينسيا، ثم إلى كتالونيا، قبل أن تودع في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث عادت إليه بعد الحرب. وفيه وجدت الفخامة الكلاسيكية لفنون عصر النهضة، حيث المطابقة شبه الكاملة بين الرسم وموضوعه، فالفن مقيد بالأمانة والدقة، والتمثيل رهين المماثلة، فالصورة البصرية شديدة التعبير عن الصورة الذهنية، ولم تخرّب بعدُ الصلة بين الأصل وكيفية إنتاجه، فذلك من مكاسب الحداثة. وجدت لوحات ضخمة تحتل صدر قاعة بكاملها، لفتتني معايير الجماليات الأنثوية، فالأجساد مملوءة، والجلود ثخينة ومطوية، والأثداء ضخمة نافرة، والأرداف شبه مترهلة، والرجال إما فسوقة قساة بقبعات عريضة، أو محاربون على خيول هائجة يشهرون سيوفا مستقيمة يطاردون المجهول.
ثم انطلقت بالقطار بعد أيام إلى طليطلة، وفيما كنت أسأل عن الكاتدرائية، أجابني شخص بالمغربية الدارجة إنها بالاتجاه الذاهب إليه برفقة زوجته وصديق أسباني، فدعاني لمرافقتهم. دليلنا المرح يدعى لويس، وقام المغربي بالترجمة من الأسبانية وإليها، لويس، وهو أستاذ جامعي من طليطلة، كان مرحاً ومتهكماً، وقادنا إلى الكاتدرائية، فبدا لي وكأنه يهمّ بالركض، ويريد شرح كلّ شيء يراه. أشار إلى مستطيلات نحاسية صقيلة بفعل الأحذية على أرض الكنيسة، وأخبرنا أنها قبور لرهبان، ثم أشار إلى السقف حيث توجد طرابيش معلقة، وقال إن أهل طليطلة يعتقدون أن هؤلاء الرهبان سيدخلون الجنة حين تسقط الطرابيش، لكنها ظلت معلقة مذ وضعت، والرهبان في انتظار وعد الرب. وصل بنا إلى قطعة نحاس أخرى، فأخبرنا أن قسا يرقد تحتها، وقد أوصى أن يكتب عليه"لا يوجد هنا إلا غبار". زرنا غرفة الذهب والمجوهرات، فظهر الثراء الكنسي مرة أخرى، وغادرنا نخترق الأزقة الضيقة المرصوفة بالحصى. أوفقنا لويس عند زاوية علّقت فيها صورة السيدة العذراء في صندوق زجاجي، حيث كومة من الدبابيس والإبر، وأنبأنا أن فتاة تعشق جندياً كانت تأتي لانتظاره في هذه الزاوية، وكان النوم يأخذها أحيانا، فتأخذ إبرة تشكك أصبعها كيلا تنام، وعاد الجندي من الحرب وتزوجا. وبنات طليطلة يأتين ويشكنّ أصابعهن بالإبر بأمل التزوج ممن يعشقن، وهذه الكومة من تلك الإبر.
مررنا بمسجد صغير يجري ترميمه، شبه ضائع بين البنايات الشاهقة. فأشار لويس إلى صخرة بيضاء أمامه، وقال إن المسيحيين كانت لهم كنيسة في المكان، ولما جاء المسلمون نزل المسيح وحفر حفرة، وأشعل سراجاً، ووضعه فيها، ولما طُرد المسلمون من طليطلة، بعد قرون، جاءت الجيوش المسيحية، فحرنَ حصان القائد في مكانه، فأمر بأن يحفر المكان فإذا بالسراج مازال مضاء. افترقت عنهم، واتجهت إلى قلب المدينة القديمة، إلى الحي اليهودي"الخدرية"الذي يماثل الحي نفسه في قرطبة. وعلى الرغم من أن أشبيلية، وقرطبة، وغرناطة، وطليطلة، بدت متشابهة إلى حد كبير، بالنسبة لي، إلا أن الأخيرة ظهرت وأبهى، وأعظم، إنها تقع على جبل أشبه بهضبة عظيمة مشجرة، وتترامي البيوت المتكونة من عدة طبقات على السفوح، تفصل بينها شوارع ضيقة، ومعظمها لا يسع لمرور السيارات، وهي من مدن المنطقة الوسطى. نضرة، عريقة، نظيفة، ومتحف عمراني كبير، تتنفس معاً عبق الماضي والحاضر في نوع من التوافق الخصب، فطرز القرون الوسطى الإسلامية لهذه المدن، وأزقتها الضيقة، لم تحل دون شيوع الروح العصرية فيها حيث الحانات الجميلة، والمطاعم الفخمة، ومحلات الأزياء الحديثة، فضلاً عن المصنوعات التقليدية، وفي مقدمتها السيوف التي كانت مشهورة في كامل أرجاء أسبانيا.
ثم انحدرت إلى الطرف الآخر من المدينة لتصفّح المنساب بهدوء بين ضفاف طينية، فإذا بي أمام منزل"غريكو"الرسام الذي عرفني إليه كازانتزاكي في سيرته الأخاذة"تقرير إلى غريكو" وقال عنه إنه "معجون من التربة الكريتية" فهما يتقاسمان دم سلالة واحدة. بوابة المنزل الخشبية مشققة، والبناء يعود إلى ما قبل أربعة قرون. وعدت إلى محطة القطار وقد بنيت على طراز المدينة القديمة، وتذكر بالمحطات التي تظهر في أفلام رعاة البقر. ويمكن توقع ظهور"كاوبوي"على حصانة من السهل المجاور. من هذا الجانب من السهل انطلق"دون كيخوته دي لا مانتشا" في رحلته الخيالية المجنونة، فإقليم المانتشا حيث تدور مغامرات الفارس النبيل متصل بطليطلة. أمضيت اليوم اللاحق في مدريد، زرت برج بيكاسو، وتمثال كولومبس الذي بني في عام 1885وقصدت النصب الضخم المجاور الذي يصور الفتوح الأسبانية للعالم الجديد، وثمة نصوص محفورة على الألواح الحجرية الكبيرة، تحتفي بالمجد الأسباني في فتح العالم، واتجهت إلى متحف للشمع. أول قاعاته خاصة بالعرب المسلمين، وارتحت طوال الظهيرة في مقهى خيخون.
ذهبتُ عصر اليوم التالي إلى"ساحة الثيران". بني المدرج المهيب، المناظر لملعب كرة القدم، في عام 1929، وشهد حضور شخصيات عظيمة. وهو البؤرة الجاذبة لمحبّي مصارعة الثيران في أسبانيا والعالم. أروقته الواسعة، وسلالمه الحجرية، ونوافذه الكبيرة، والمقاعد الخشبية العتيقة، ثم شرفته المندفعة في الفضاء، هيأتني لحفلة من عنف، وسرعان ما امتلأ المكان الذي يسع لعشرين ألف متفرج. بدأت المصارعة بجولات ست أو سبع. وتتألف الجولة من مراحل، تنطلق الأولى بدخول المصارع الذي يستفزّ الثور لخمس دقائق من أجل إرهاقه من جماعة من اللاعبين الذين يحتمون خلف مساند من الأسمنت إذا هاجمهم الثور الهائج الذي فوجئ بأنه وسط عالم غريب عنه، ثم يدخل فارسان دُرّع حصاناهما بالجلود الثخينة، وبيد كل منهما رمح طويل، ترافقهما جماعة أخرى من اللاعبين، فيستفزان الثور الذي ينطح درع الحصان، وخلال ذلك يغرز الفارس رمحه في سنامه، ثم يمعن في تمزيق جرحه، وتنتهي الجولة، ليظهر لاعبان يحملان رمحين، يحاول كل منهما غرز رمح في السنام المثخن بالجراح، فتتكاثر الرماح القصيرة التي تمزق السنام، وتظل نابتة في أعلاه، أو متدلية، فتعمّق الأذى، وينسحب هؤلاء ليظهر المصارع الذي يتقصّد إرهاق الثور برايته الحمراء وسيفه، فالحيوان لا يميز بين الألوان، ويهجم على غمامة معتمة أمامه، وكلما تحرك زادت الرماح تمزيقاً فيه.
ويعود المصارع لأخذ سيف طويل، ورفيع، ومستقيم، ويحاول بالخداع أن يجر الثور إلى وسط الدائرة، تحت أنظار جمهور تدفّق هياجه البدائي، فيتحيّن الفرصة لطعنة تناسبه، وبعد أن يترنح الثور تعباً يستغل الفرصة فيغرز سيفه في أعلى السنام الذي كان أحد الفرسان فتحه بالرمح من قبل، فيغرز الرمح فيه إلى أن يبلغ القلب والأحشاء، وكلما اختفى السيف في جسد الثور كانت الضربة موفقة، وتلاقي تشجيعاً هوسيا من المتفرجين الذين انفلت حماسهم الوحشي. وأخيرا يقوم المصارع بأخذ سيف جديد، فيما خصمه يتهاوى مترنحا، مثخنا، فيتخير طعنة في مخه، وهي الضربة القاتلة التي يسقط إثرها صريعاً بعد أن ينغرز السيف في هامته، وإذا ظل يتحرك يتقدم رجل يحمل خنجراً قصيرا فيطعنه طعنات سريعة قاتلة في الرأس خلف القرون إلى أن ينهار صريعا، فيزفر زفرته الأخيرة، والدماء تشخب من فمه ورأسه، وتتقدم خيول يمتطيها فرسان بأزياء ملونة، فيُسحل الثور بالحبال من قرنيه في حركة استعراضية كرنفالية دائرية إلى الخارج لتبدأ جولة جديدة.
ترجع هذه اللعبة إلى حقبة مغرقة في القدم، ويرجّح أنها عرفت منذ نحو ستة آلاف سنة، وثبت شيوعها في عهد يوليوس قيصر أحد أشهر أباطرة الدولة الرومانية، ويورد لسان الدين بن الخطيب في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي، وهو من غرناطة، وصفا بارعا لها، وقد كانت الكلاب تقوم مقام اللاعبين المُنهكين للثور" يُطلق الثور، أو بقر الوحش، ثم تطلق عليه كلاب اللان المتوحشة، فتأخذ في نهش جسمه وأذنيه، وتتعلق بهما كالأقراط، وذلك تمهيدا للقاء المصارع الذي يكون فارسا مغوارا يصارع الثور، وهو على فرسه، ثم يقتله في النهاية برمحه" وتاريخ مصارعة الثيران غامض، وملتو، وأقرب إلى أن يكون، في أصوله، طقسا للقتل. ومن المستحيل كتابة تاريخ موضوعي لأي فعل معمّد بالدم. وتمارس المصارعة بنسب متباينة في أسبانيا، والبرتغال، والمكسيك، وفرنسا، وكولومبيا، والأكوادور، وفنزويلا، واستوحاها رسامون كبار منهم غويا، وبيكاسو الذي كان مغرما بها.
عرفت مصارعة الثيران تطورات كثيرة، فالراية الحمراء التي يضلل بها المصارع الثور أضيفت في عام 1725، ويُسمى المصارع matador أما الفارسان اللذان يخزان الثور بالرماح غرض إنهاكه وإغضابه، فكل منهما يسمى Picador. وطول السيف المستخدم في الطعن هو متر واحد، وقد صُمِّم بحيث يخترق قلب الحيوان، وأغلب المصارعين لا يوفّقون في معرفة مكان القلب، فيمزقون رئتي الثور فلا يموت فورا، وإنما تتلاشى حياته بسبب تمزيق أعضائه الحيوية، ويصبح احتضاره عذابا مضاعفا. وقد تنتهي اللعبة بطقس انتصار رمزي يقطع فيه المصارع أذن الثور وذيله، ويستعرضهما أمام الجمهور، ويحتفظ بهما ذكرى مدى الحياة، وفي حال ما أدى الثور عرضًا مثيرا، وتميز بالمطاولة والشراسة، فيُكرم بأن يُسحل في عرض أمام الحاضرين بخيول أعدت لهذا الغرض. ويمثل الأميركيون أعلى نسبة في حضور هذه الألعاب بين الآخرين، وقد جلست جواري أميركية شقراء طوال العرض، كانت تلتذ منفعلة بالمنعطفات المأساوية الحاسمة لمصائر الثيران، وتصدر صفيرا في تشجيع المصارعين، وتخبط المقعد بيديها ومؤخرتها حينما يشنّفون قاماتهم بكبرياء أمام كدس بشري شحنة هوس الانفعال. ومعلوم أن همنغواي كان من أشهر محبي هذه اللعبة بين الكتاب.
وبدأت مصارعة الثيران تواجه بمعارضة شرسة من دعاة الرفق بالحيوان، وكشفت أسرار كثيرة حول الطريقة التي تربى الثيران بها، إذ يحبس الثور أربعا وعشرين ساعة في غرفة مظلمة وضيقة قبل الموعد، فلا يتمكن من رؤية شيء، ولا يسمح له بالحركة، ثم يطلق فجأة وسط الضوء والصياح، فيصاب بالحيرة، وتشلّه المفاجأة، فيما تمعن الرماح في طعنه. وهذه الحال تظهر الثور بمظهر عدواني، والحقيقة فقد دهمه ذهول، واضطراب. وتُخفى عن الجمهور كل هذه المقدمات. وليس من الغريب أن نجد تنويعا لهذه اللعبة في بقايا المستعمرات الأسبانية والبرتغالية في أميركا اللاتينية وآسيا، بل في بلاد الخليج العربي حيث افتتح البرتغاليون الحقبة الاستعمارية في القرن الخامس عشر، ففي الفجيرة، على الساحل الشرقي من دولة الإمارات، تمارس مصارعة الثيران، لكنها بين الثيران فقط، وتقام بعد صلاة العصر من كل جمعة في الأصياف غالبا. والأهالي يعدونها من تراث أجدادهم. وتجري عليها رهانات بين الحاضرين، والمنظّم الذي يقوم بالتعليق والتشجيع وإثارة الحيوانات يسمى"مثير الفتن".
وهذه اللعبة دموية، وشنيعة، لأنها ترتكز على المفارقة غير الأخلاقية بين القوة البريئة والغدر المريع، فالثور الذي رُبِّي في مكان منعزل يفاجأ حينما يُدفع به وسط آلاف الناس الهائجين، وما دام يمتلك القوة، فاللاعبون يخادعونه، ويحتمون من اندفاعاته خلف حواجز الأسمنت، فيزداد تشتتا لأن الهجمات تأتيه من الجهات كافة. ويحاول اللاعبون ويبلغ عددهم أكثر من عشرة بين مصارع، وفارس، ومساعد، ورامح، إنهاك الثور الذي لا يعرف من أين يدهمه الخطر. تبدأ الطعنات تنهال عليه يرافقها استفزاز، وكل حركة منه تضاعف تمزيق جسده بالرماح المنغرزة في سنامه، فيشترك هو وخصومه في التنكيل بنفسه، وهذا يجافي أي مبدأ ممكن لأي منازلة، فكيف بلعبة!! وكلما خارتْ قواه تضاعف غدر خصومه، ولكن الأمر الملفت للنظر هو مشاركة الجمهور المرضيّة في تشجيع المصارع لإلحاق أقصى درجات الأذى بالحيوان الذي كلما مرّ الوقت أصبح خصماً لدوداً للمصارع، والجمهور على حد سواء.
وحينما تأتي ضربة القلب القاتلة، ثم غرزة الدماغ التي يخرّ بعدها الثور صريعا، يبلغ هياج المشجعين ذروته، فتخيّم نشوة العنف الأعمى في الملعب كله، فبدل أن تحل الشفقة على الضحية تندلع الحماسة الانتقامية المتصاعدة ضدها. وطوال الجولات الست أو السبع كنتُ حائراً في تفسير هذه الروح العدائية تجاه براءة مطلقة. ولم يبق أمامي سوى تفسير ثقافي، وهو أن الثور يمثل رمزاً شريراً في طيات اللاوعي الجمعي للأسبان، فوجدتني انظر باشمئزاز لا يمكن طمره إلى بشر تتدافع مشاعرهم العدوانية باطراد ضد الحيوان الذي ينفث من فمه مزيجاً من الدم والزَبد، وهو يرغي في مشهد مروع، فكأن الجمهور يتشفّى من كائن ارتسمت نهايته، وأصبح التخلّي عنه شعورا يستبطن الرغبات الدفينة التي يمثلها الانفضاض عن القوي لحظة انهياره، كما يقع في حالات سقوط الطغاة حيث أول من يتوارى مناصروهم. فهل يتماهى الجمهور مع بطولة زائفة يمثلها المصارع الذي وصل إلى قتل الخصم عبر سلسة مكشوفة من الخدع والمساعدين؟ ولماذا يضج الآلاف بصيحات الاهتياج كلما ترنح الثور الذي يبدو سلوكه غاية في الاستقامة والبراءة الغبية؟ ولماذا يصيحون هاتفين"أُولي"بصوت واحد، فهل لذلك علاقة بنداء"الله"الموروث عن العرب المسلمين، وقد حرّف اللفظ؟ وهل يتطهّر الجمهور عبر التأييد الواضح للمصارع من خمول أو ذنب أو حينما يترنح الخصم مضرجا بدمائه؟.
نشرت هذه المادة بعد استحصال موافقة كاتبها الصديق العزيز الدكتور عبدالله ابراهيم وقد أهداها للمجلة واصدقائه في كركوك .

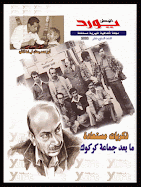



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق